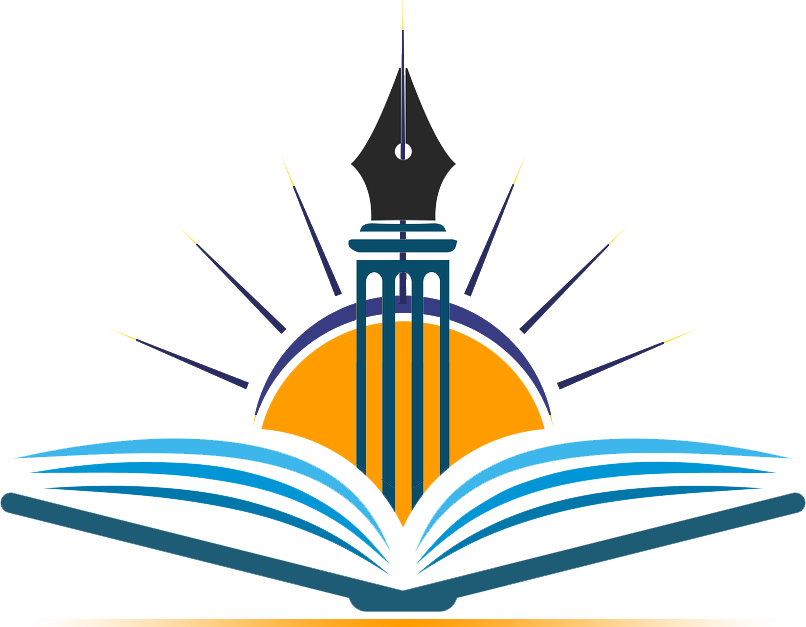المقدّمة
المقدّمة
○ التعريف بعلم الاُصول.
○ الوضع.
○ الدلالة على المعنى المجازيّ.
○ الإطلاق الإيجاديّ.
○ الخلط الواقع في تبعيّة الدلالة للإرادة.
○ كيفيّة وضع المركّبات.
○ علامات الحقيقة والمجاز.
○ الحقيقة الشرعيّة.
○ الصحيح والأعمّ.
○ الاشتراك.
○ المشتقّ.
المقدّمة
۱
التعريف بعلم الاُصول
○ تعريف علم الاُصول.
○ موضوع علم الاُصول.
○ تقسيم الأبحاث الاُصوليّة.
تعريف علم الاُصول
الجهة الاُولى ـ في تعريف علم الاُصول: إنّ هناك علوماً عديدة نحتاج إليها في مقام استنباط الحكم الشرعيّ كعلم الرجال الذي يتحدّث عن وثاقة الرواة، وعلم اللغة الذي يتحدّث عن معاني كلمات نحتاج إلى فهمها في الاستنباط، والمنطق الذي يبيّن أساليب الاستدلال وما إلى ذلك، فهل إنّ علم الاُصول الذي نحتاج إليه أيضاً في مقام الاستنباط يمتاز بمايز فنّيّ عن سائر العلوم المحتاج إليها، أو أنّه ليس إلاّ مجرّد تجميع لمباحث شتّى كنّا نحتاج إليها في الاستنباط ولم تكن مدرجة في العلوم الاُخرى، فاضطررنا إلى إيجاد علم آخر نسمّيه بعلم الاُصول يشتمل على ما لم يشتمل عليه سائر العلوم ممّا تمسّ به الحاجة للاستنباط؟
(۱) راجع أجود التقريرات، ج ۱ المشتمل على تعاليق السيّد الخوئيّ، ص ۳، وفوائد الاُصول، ص ۱۸، طبعة جماعة المدرّسين.
صغرى لكبرى حجّيّة الظهور، فتتمّ على أساس هذه الصغرى وتلك الكبرى عمليّة الاستنباط.
ومنها: مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، فإنّنا إن انتهينا فيه إلى عدم الجواز، فهذا معناه: أنّ الأمر والنهي المتصادقين على مورد واحد متعارضان كصلّ ولا تغصب مثلاً، فيكون ذلك صغرى لبعض كبريات باب التعارض كالكبرى القائلة بتقديم المطلق الشمولي على البدلي عند التعارض مثلاً، وبذلك يتمّ الاستنباط. وإن انتهينا فيه إلى الجواز كان هذا معناه: أنّ إطلاق الأمر وإطلاق النهي لمادّة الاجتماع محفوظان، وهذا ينقّح صغرى لكبرى حجّيّة الإطلاق. ومنها: مبحث: أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه، أو لا؟ فإن قلنا بالاقتضاء فبما أنّ النهي عن الضدّ ليس حكماً فقهيّاً؛ لأنّه نهي غيري لا يقبل التنجيز والتعذير فالنتيجة الفقهيّة إنّما هي بطلان الضدّ لو كان عبادة مثلاً، فهذا البحث ينقّح صغرى لكبرى كون النهي في العبادات موجباً للبطلان مثلاً. وإن قلنا بعدم الاقتضاء كان معنى ذلك تتميم إطلاق أمر الضدّ مثلاً، فيكون صغرى لكبرى حجّيّة الإطلاق. وقد اتّضح بما ذكرناه: أنّ هذه المؤاخذة الاُولى بقيت إلى الآن بلا جواب؛ ولهذا عدل بعض عن هذا التعريف إلى تعاريف اُخرى. المؤاخذة الثانية: ما جاء في الكفاية ضمناً من أنّ هذا التعريف لا يشمل الاُصول العمليّة؛ لأنّها ليست بصدد إحراز الحكم، وإنّما هي تعيّن الوظيفة بعد فرض الشكّ في الحكم. ولهذا أضاف صاحب الكفاية إلى التعريف جملة ( أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) دفعاً لهذا النقص. إلاّ أنّ هذه الإضافة لا تفيد شيئاً؛ إذ المقصود إنّما هي معرفة الجامع المنطبقعلى كلّ الأبحاث الاُصوليّة، أمّا لو فرض العطف بـ (أو) فبالإمكان أن يعطف كلّ مباحث الاُصول بـ (أو)، ويقال: إنّ علم الاُصول هو ما يبحث عن كذا، أو كذا، أو كذا، فلا نحتاج إلى تعريف معيّن.
وهذه المؤاخذة لها جوابان: الأوّل: ما عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّه لا داعي إلى حمل الحكم في التعريف على الحكم الواقعيّ، بل نحمله على ما يعم الحكم الظاهريّ، والاُصول العمليّة تفيد في مقام استنباط الحكم الظاهريّ. وهذا الجواب إن تمّ في الاُصول الشرعيّة فهو لا يتمّ في الاُصول العقليّة كقبح العقاب بلا بيان؛ إذ ليست إلاّ تنجيزاً أو تعذيراً عقليّاً، ولا تكون حكماً شرعيّاً واقعيّاً أو ظاهريّاً. الثاني: أن يقصد باستنباط الحكم الشرعيّ إقامة الحجّة عليه، بمعنى التنجيز والتعذير، لا الاستنباط بمعنى الكشف والإحراز، وإقامة الحجّة بهذا المعنى كما تثبت بإحراز الحكم الواقعيّ أو الظاهريّ تثبت بالاُصول العقليّة أيضاً. المؤاخذة الثالثة: أنّ هذا التعريف يشمل القواعد الفقهيّة من قبيل قاعدة الفراغ، وأصالة الصحّة، ونفي الضرر والحرج، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ونحو ذلك؛ فإنّها أيضاً تفيد أحكاماً شرعيّة. إلاّ أنّ هذه المؤاخذة أيضاً قابلة للدفع؛ وذلك لأنّ القواعد الفقهيّة: إمّا أن يكون مفادها إثبات الموضوع كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث يقول: ( بلى قد ركعت ) مثلاً، أو أصالة الصحّة الحاكمة باجتماع شرائط الصحّة، وإمّا أن يكون مفادها إثبات الحكم الكلّيّ الإلهيّ كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قاعدة نفي الضرر والحرج.
(۱) لا يخفى: أنّه لو فرض هذا جعلاً واحداً، واُخرج من علم الاُصول بهذه النكتة، فدليل البراءة أيضاً يدلّ على جعل واحد، ويلزم خروج البراءة عن علم الاُصول.
ولو قيل: إنّ دليل البراءة تستنبط منه جعول عديدة؛ لأنّه اقتطاع ظاهريّ من الجعول الإلزاميّة العديدة. وبكلمة اُخرى: إنّ نفي الإلزام يتعدّد بتعدّد الجعول المنفيّة، قلنا: إنّ نفي الضرر والحرج أيضاً اقتطاع واستثناءٌ واقعيّ من أحكام عديدة، فكلّ حكم يصبح ضرريّاً أو حرجيّاً ينفى بذلك، فيتعدّد ذلك بتعدّد المستثنى منه.
وقد ذكر اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في أوّل بحث حجّيّة خبر الواحد الذي بحثه في زمان سابق
مفاده البراءة كما يقال في دليل الانسداد من أنّ الاحتياط التامّ حرجيّ فيُنفى بنفي الحرج، وهذا معناه ثبوت البراءة ولو في الجملة، فقاعدة نفي الحرج دخلت هنا في علم الاُصول، فإنّ البراءة من علم الاُصول؛ إذ هي تنفي جعولاً عديدة، فقد وقعت في طريق استنباط أحكام عديدة. وهذا لا ضير فيه؛ إذ أيّ فرق في اُصوليّة البراءة بين أن يكون دليلها « رفع ما لا يعلمون » أو يكون دليلها نفي الحرج؟
فقد تحصّل: أنّ المؤاخذة الثانية والثالثة قابلتان للدفع. نعم، بقيت المؤاخذة الاُولى بلا جواب؛ ولهذا عدل بعض إلى تعريفات اُخرى ونذكر في المقام تعريفين: →
→
من الدورة السابقة ( ونحن حذفناه هناك فيما طبعناه من التقرير ) في وجه خروج قاعدة نفي الضرر: أنّها ـ في الحقيقة ـ ليست قاعدة تستنبط منها الأحكام، بل هي تجميع أحكام إلهيّة واقعيّة كثيرة جمعها الدليل في عبارة واحدة.
أقول: لو كان هذا هو الوجه لخروج قاعدة نفي الضرر عن علم الاُصول، للزم أيضاً خروج البراءة الشرعيّة عن علم الاُصول، فهي أيضاً ليست قاعدة تستنبط منها الجعول، وإنّما هي تجميع لعدد من النفي الظاهريّ والاقتطاع الظاهريّ المتعدّد بتعدّد المقتطع منه.
والوجه الصحيح في خروج قاعدة نفي الضرر عن علم الاُصول، والذي به تختلف عن البراءة ما ذكره(رحمه الله) أيضاً في أوّل بحث خبر الواحد ( وقد حذفناه هناك ) وأعاده في بحث الاستصحاب من أنّ قاعدة نفي الضرر قد اُخذت فيها مادّة معيّنة من موادّ الفقه، وسيأتي في التعريف المختار: أنّ القواعد الاُصوليّة لا تؤخذ فيها مادّة معيّنة من موادّ الفقه. ولا نفسّر مادّة الفقه بما سيأتي هنا من اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في القيد الأوّل من قيود التعريف المختار من تفسيرها بفعل معيّن من أفعال المكلّفين كالصلاة والصوم حتّى يقال: إنّه لم توجد في قاعدة نفي الضرر مادّة معيّنة، بل نفسّرها بالتفسير الذي ذكره اُستاذنا(رحمه الله)في أوّل بحث الاستصحاب من أنّ مقصودنا بموادّ الفقه: كلّ عنوان أوّليّ أو ثانويّ متعلّق لحكم واقعيّ، كالصعيد مثلاً الذي هو عنوان أوّليّ، وكالضرر الذي هو عنوان ثانويّ.
أحدهما للسيّد الاُستاذ دامت بركاته والثاني للمحقّق العراقيّ(قدس سره).
تعريف السيّد الاُستاذ لعلم الاُصول: أمّا تعريف السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) فهو: أنّ القاعدة الاُصوليّة هي التي يستنبط منها الحكم بمفردها مع إحراز صغراها، أي: من دون ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى، فحجّيّة خبر الثقة مثلاً تكفي وحدها مع إحراز صغراها ـ وهي ورود خبر ثقة ـ للاستنباط، بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى، وظهور الأمر في الوجوب وحده يكفي بعد إحراز صغراها ـ أي: الأمر ـ للاستنباط، بلا ضمّ قاعدة اُخرى اُصوليّة. وهذا بخلاف وثاقة زرارة مثلاً، فإنّها لا تكفي للاستنباط ما لم تضمّ إليها قاعدة حجّيّة خبر الثقة، وبخلاف دلالة لفظ « الصعيد » على التراب مثلاً أو مطلق وجه الأرض، فإنّها لا تكفي في استنباط الحكم ما لم نعرف أنّ الأمر للوجوب، فقيد « عدم الحاجة إلى قاعدة اُصوليّة اُخرى » يرفع المؤاخذة الاُولى عن التعريف(۱). ثُمّ أورد على نفسه اعتراضات نذكر منها اعتراضين: الأوّل: أنّ الأبحاث الاُصوليّة المنقّحة لصغريات الظهور من قبيل: ظهور الأمر في الوجوب، والنهي في الحرمة بحاجة إلى قاعدة اُخرى اُصوليّة، وهي قاعدة حجّيّة الظهور. وأجاب على ذلك بأنّ قاعدة حجّيّة الظهور ليست اُصوليّة؛ لأنّ حجّيّة الظهور
(۱) راجع المحاضرات للفيّاض، ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ(رحمه الله)، ص ٤ و ۹ ـ ۱٠، وراجع الدراسات، ج ۱، ص ۲٤ بحسب طبعة مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميّ.
أمر بديهيّ واضح لدى أيّ إنسان عرفيٍّ، ولا تحتاج إلى أيّ بحث اُصوليّ في ذلك(۱).
الثاني: أنّ مبحث اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه ثمرتة الفقهيّة عبارة عن بطلان الضدّ إذا كان عبادة لو قلنا بالاقتضاء، وهذا موقوف على قاعدة اُصوليّة اُخرى وهي: أنّ النهي في العبادات يوجب البطلان.
(۱) لم أجد هذا الإشكال والجواب على شكل إشكال وجواب لا في المحاضرات ولا في الدراسات.
نعم، صرّح في المحاضرات (ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص ۲) بأنّ حجّيّة الظهور خارجة عن المسائل الاُصولية؛ إذ لا خلاف في حجّيّتها بين اثنين من العقلاء، ولم يقع البحث عنها في أيّ علم وإن وقع الكلام في موارد ثلاثة، هي:
الأوّل: في أنّ حجّيّة الظهور هل هي مشروطة بعدم الظنّ بالخلاف، أم الظنّ بالوفاق، أم لا هذا ولا ذلك؟
الثاني: في ظواهر الكتاب وأنّها هل تكون حجّة أم لا؟
الثالث: في أنّ حجّيّة الظواهر هل تختصّ بمن قصد إفهامه، أم تعمّ غيره أيضاً؟
وقريب من ذلك ما ورد في الدراسات (الصفحة الماضية والطبعة الماضية).
فلعلّ هذين المقطعين إشارة إلى ما نقله اُستاذنا الشهيد عن اُستاذه السيّد الخوئيّ(رحمهما الله).
وأخيراً رأيت تعبيراً صريحاً في كون ذكر السيّد الخوئيّ(رحمه الله) لخروج بحث حجّيّة الظواهر عن علم الاُصول لدفع الإشكال عن اُصوليّة الأبحاث الاُصوليّة المنقّحة لصغريات الظهور من قبيل ظهور الأمر في الوجوب، وذلك فيما طبع أخيراً من كتاب الهداية في الاُصول لمقرّر أقدم من السيّد عليّ صاحب الدراسات(رحمه الله)، وهو المرحوم الشيخ حسن الصافيّ الإصبهانيّ، ج ۱، ص ۲۱ ـ ۲۲. فهو صريح في كون ذلك دفعاً لذاك الإشكال، موضّحاً: أنّ عدم النزاع من قبل أحد في حجّيّة الظواهر وعدم الشكّ من قبل أحد في ذلك يدفع الإشكال برغم الخلاف في حجّيّة عدد من الظهورات؛ وذلك لأنّ كون قضيّة ما كافيةً لاستنباط الحكم الكلّيّ الإلهيّ في الجملة كاف في اُصوليّتها، فنحن نفرض الكلام في أمر ونهي داخلين في القدر المتيقّن من حجّيّة الظهور، أي: في المقدار الذي لم يشكّ أحد في حجّيّته.

(۱) راجع المحاضرات، ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص ۱۲.
ذاك التعريف، بل يحتاج إلى إخراج بعض المباحث الاُخرى، فمثلاً يوجد في علم الاُصول مباحث عن أقوى الظهورين المتعارضين، كالبحث عن أقوى الظهورين في العموم الوضعي والإطلاق الحكميّ، أو في العموم الشموليّ والبدليّ، أو في المنطوق والمفهوم، في حين أنّ الاستنباط من هذه الأبحاث موقوف على ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى، وهي قاعدة حجّيّة الجمع العرفيّ؛ إذ لولاها لما أفادتنا أقوائيّة أحد الظهورين، فلم ينطبق تعريف علم الاُصول على هذه المباحث إلاّ أن يلتزم أيضاً بخروج قاعدة حجّيّة الجمع العرفيّ.
الثالثة: أنّنا لو قلنا بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه، فهذا لا يكفي في استنباط صحّة الضدّ العبادة؛ إذ العبادة يجب أن تكون قربيّة، والأمر بالشيء لا يجتمع معه الأمر بضدّه في عرضه، فلا بدّ: إمّا من إثبات الأمر الترتّبيّ، أو إثبات: أنّ الملاك يبقى بعد سقوط الأمر حتّى يكتفى بقصد الملاك، وكلاهما قاعدة اُصوليّة. وعلى أيّ حال، فقد تحصّل: أنّ التعريف الذي جاء به السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) تكون المؤاخذة الاُولى مسجّلة عليه؛ إذ عدم الحاجة إلى ضمّ قاعدة اُصوليّة اُخرى في بعض الأحيان قد يوجد في مثل قاعدة ظهور « الصعيد » في وجه الأرض ونحو ذلك. وأمّا المؤاخذة الثانية فقد دفعها السيّد الاُستاذ ( دامت بركاته ) بمثل ما ذكرناه من أنّنا نقصد بالاستنباط مطلق تحصيل المنجِّز والمعذِّر تجاه الحكم(۱). ولكن هذا الجواب لا ينسجم مع مبانيه، فإنّه إذا جعل الاستنباط بمعنى مطلق
(۱) راجع المحاضرات، ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص ٦.
إثبات التنجيز أو التعذير تجاه الحكم، لم يصحّ ما يقوله من خروج مبحث حجّيّة القطع عن علم الاُصول؛ لأنّ ذلك لا يقع في طريق استنباط الحكم؛ إذ فرض القطع هو فرض الاتّصال بالحكم مباشرة والوصول إليه، فإنّ هذا يرد عليه حينئذ: أنّ مبحث حجّيّة القطع متكفّل لبيان تنجيز الحكم وتعذيره بالقطع، وقد فرض: أنّ الاستنباط قصد به إقامة الحجّة بالمعنى الأعمّ، أي: إقامة التنجيز والتعذير. إذن فيدخل مبحث حجّيّة القطع في علم الاُصول.
على أنّه بعد دخول حجّيّة القطع في علم الاُصول لا يبقى مجال لدخول سائر القواعد الاُصوليّة، كالبراءة، والاستصحاب، وأيّ قاعدة اُخرى في علم الاُصول حسب مبانيه دامت بركاته؛ لأنّها جميعاً بحاجة إلى حجّيّة القطع وقد فرض: أنّ القاعدة الاُصوليّة يجب أن لا تحتاج في مقام الاستنباط منها إلى قاعدة اُصوليّة اُخرى، إذن فكلّ قواعد الاُصول أو جلّها خرجت عن علم الاُصول. إلاّ أن يلتزم بخروج حجّيّة القطع عن علم الاُصول، لا بملاك عدم وقوعها في طريق الاستنباط، بل بنفس الملاك الذي أخرج به حجّيّة الظواهر عن علم الاُصول، وهو كونها أمراً واضحاً لم يقع في أصلها خلاف، وإن وقع الخلاف في بعض تفاصيلها، كما وقع ذلك في حجّيّة الظهور أيضاً. وأمّا المؤاخذة الثالثة ـ وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة ـ فقد أجاب عليها بأنّنا نقصد بالاستنباط: الاستنباط التوسيطيّ، لا الاستنباط التطبيقيّ. وتوضيح ذلك: أنّ الاستنباط قد يكون تطبيقيّاً بمعنى كون النتيجة قطعة من المقدّمة، ومصداقاً لها، وتطبيقاً لها، وهذا شأن الاستنباط من القواعد الفقهيّة، فاستنباط الضمان في البيع الفاسد من « قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » عبارة عن تطبيق تلك القاعدة العامّة في إحدى مواردها، وتكون النتيجة ـ وهيالضمان في البيع الفاسد ـ حصّة من الضمان في كلّ عقد فاسد يضمن بصحيحه، وقد يكون توسيطيّاً بمعنى: أنّ النتيجة ليست تطبيقاً للمقدّمة وحصّة منها، وإنّما تستنتج من المقدّمة على أساس وجود الملازمة بينها وبين المقدّمة من قبيل دلالة الأمر على الوجوب التي يستنتج منها وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً، فالنتيجة هنا ليست حصّة من المقدّمة؛ فإنّ النتيجة حكم شرعيّ، والمقدّمة أمر لُغويّ مثلاً، وهما أمران متباينان، لكن يوجد بينهما تلازم بعد فرض حجّيّة الظهور، فبهذا تثبت النتيجة، والمسائل الاُصوليّة دائماً تقع في طريق الاستنباط بمعنى الاستنباط التوسيطيّ، بخلاف القواعد الفقهيّة، فإذا قصدنا من الاستنباط الاستنباط التوسيطيّ ارتفعت المؤاخذة.
أقول: إنّ الاستنباط التوسيطيّ أيضاً نقسّمه إلى قسمين: أحدهما: أن تكون الملازمة بين المقدّمة وبين حكم كلّيّ إلهيّ، فنستنتج الحكم الكلّيّ الإلهيّ من المقدّمة من قبيل الملازمة بين دلالة الأمر على الوجوب ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال. والثاني: أن لا تفرض ملازمة بين المقدّمة والحكم الكلّيّ، بل يفرض: أنّ المقدّمة منقِّحة لموضوع ذلك الحكم، فيستنبط الحكم الجزئيّ في المقام عن طريق إحراز فعليّة موضوعه من قبيل: أنّ قاعدة صحّة المعاطاة تنقّح موضوع نفوذ التصرّفات فيما انتقل إليه بالمعاطاة مثلاً، فإنّ موضوع نفوذها هو الملك، وقد ثبت بقاعدة صحّة المعاطاة. فإن كان مقصوده (دامت بركاته) من الاستنباط في تعريف علم الاُصول الاستنباط التوسيطيّ من القسم الأوّل، فقط لزم خروج بعض المسائل الاُصوليّة من قبيل اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه وعدمه، حيث إنّ الثمرة الفقهيّة لهذه المسألةعند السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) عبارة عن بطلان الصلاة وصحّتها، بينما هذا إنّما يكون على أساس تنقيح المقدّمة لموضوع الحكم، حيث إنّ الحرمة في العبادات موضوع للبطلان، وعدم الحرمة شرط في الصحّة، وهذه القاعدة تنقّح الحرمة أو عدم الحرمة، فيتعيّن البطلان أو الصحّة.
وإن كان مقصوده الاستنباط التوسيطيّ ولو من القسم الثاني، دخلت كلّ القواعد الفقهيّة في علم الاُصول؛ إذ هي تنقّح موضوعات أحكام اُخرى، فمثلاً قاعدة صحّة المعاطاة وإن كان استنباط صحّة البيع المعاطاتيّ منها استنباطاً تطبيقيّاً، لكن يستنبط منها أيضاً نفوذ تصرّفات المشتري وجوازها في المبيع مثلاً على أساس: أنّ موضوع هذه الأحكام هو ملكيّته للمبيع، وقاعدة صحّة المعاطاة تنقّح هذا الموضوع، فهذا استنباط توسيطيّ من القسم الثاني، وكذلك يستنبط منها وجوب دفع القيمة إلى البايع؛ لأنّ موضوعه تحقّق البيع الصحيح، وهذا ما تنقّحه قاعدة صحّة المعاطاة، وكذلك قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وإن كان استنباط الضمان في البيع الفاسد منها استنباطاً تطبيقيّاً، لكن استنباط وجوب أداء القيمة عند تلف المبيع منها الذي معناه وجوب أداء الدين استنباط توسيطيّ على أساس تنقيح الموضوع؛ حيث إنّ وجوب أداء الدين حكم تكليفيّ موضوعه الدين والضمان، وقد ثبت هذا الدين والضمان بهذه القاعدة. وهكذا الكلام في سائر القواعد الفقهيّة. وهذا الإشكال إنّما أوردناه بناءً على ما أفاده السيّد الاُستاذ في المقام من أنّ ثمرة قاعدة « اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه وعدمه » بطلان الضدّ العبادة وعدمه. والواقع: أنّه كان المفروض أنّ القاعدة الاُصوليّة هي التي يستنبط منها الحكمالكلّيّ الإلهيّ، لا التي يستنبط منها موضوع الحكم، ولا ينتقض ذلك بالقواعد الفقهيّة التي تستنبط منها أحكام جزئيّة استنباطاً تطبيقيّاً من القسم الثاني.
وأمّا كون ثمرة ( اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه وعدمه ) بطلان الضدّ العبادة وعدمه، فنحن لا نقول به. وتوضيح ذلك: أوّلاً: أنّ بالإمكان أن يقال: إنّ ثمرة هذا البحث هي معرفة: أنّ أضداد الواجبات هل هي حرام أو لا؟ وهي جعول كلّيّة إلهيّة مشكوكة تستنبط من قاعدة الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه. والسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ إنّما عدل عن هذه الثمرة إلى مسألة بطلان الضدّ العبادة على أساس نكتة: أنّ حرمة الضدّ غيريّة لا يترتّب عليها أيّ تنجيز أو تعذير، أو ثواب أو عقاب، فليست هي ثمرة فقهيّة. ولكن هذه النكتة لو التفتنا إليها عرفنا أنّ هذا النهي لا يبطل أيضاً الضدّ إذا كان عبادة؛ إذ هو نهي غيري صرف، وليس له أيّ تنجيز أو تعذير، أو تبعيد أو تقريب، ولهذا ذهب السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) إلى عدم بطلان الضدّ العبادة(۱)، وحينئذ لو لم نجد لهذا البحث ثمرة اُخرى فقهيّة، نلتزم بعدم كونه بحثاً اُصوليّاً، ولا ضير في ذلك بعد فرض عدم ترتّب ثمرة
(۱) ذهب السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ـ على ما في المحاضرات، ج ٤٤ من موسوعة الإمام الخوئيّ ص ۳۸۳ ـ ۳۸٤ ـ إلى صحّة الضدّ العباديّ الواجب، سواء كان تقدّم الأمر بضدّه عليه لأجل أنّ العبادة كانت موسّعة وضدّها مضيّقاً أو لأجل أهمّيّة ضدّها. أمّا في الفرض الأوّل فيكفي في صحّة العبادة تعلّق الأمر بالطبيعة الجامعة بين الفرد المزاحم والأفراد المتأخّرة، ولا تنافي بين الأمرين. وأمّا في الفرض الثاني فالقول بالترتّب يثبّت الأمر ويحلّ الإشكال.
فقهيّة عليه(۱)، وأمّا لو لم نلتفت إلى هذه النكتة إذن نجعل الثمرة الفقهيّة لهذا البحث نفس حرمة الضدّ وعدمها، ولا إشكال أيضاً.
وثانياً: أنّنا نقول: إنّ ثمرة هذا البحث هي: أنّه لو كان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، إذن لا يكون الضدّ واجباً بنحو الأمر الترتّبي؛ لأنّ الوجوب لا يجتمع مع الحرمة ولو كانت غيريّة، ولو لم يكن الأمر به مستلزماً للنهي عن ضدّه صحّ تعلّق الأمر الترتّبي بالضدّ المهمّ، أي: الأمر به على تقدير مخالفة الأهمّ، وهذا استنباط لحكم كلّيّ إلهيّ، وهو وجوب الضدّ ترتّباً أو عدمه.تعريف المحقّق العراقيّ لعلم الاُصول:
وأمّا تعريف المحقّق العراقيّ(قدس سره) ( وهو(قدس سره) ركّز على دفع المؤاخذة الاُولى ) فقد ذكر(رحمه الله): أنّ القاعدة الاُصوليّة تكون قاعدة دخيلة في الاستنباط بنحو تكون نفس القاعدة حينما يستنبط منها حكم فقهيّ متعرّضةً للحكم أو لكيفيّة تعلّقه بموضوعه وناظرة إلى ذلك، فمثلاً قاعدة دلالة الأمر على الوجوب مفادها ابتداءً هو إثبات الوجوب، في حين أنّ وثاقة الراوي أو ظهور كلمة « الصعيد » لا يتعرّضان ابتداءً للحكم وإن كنّا نستفيد منهما في مقام استنباط الحكم، ولذا لو غضضنا النظر عن عالم الأحكام لا يبقى معنىً لقولنا: ( الأمر يدلّ على الوجوب )؛ إذ الوجوب هو حكم من
(۱) ولنا أن نقول: إنّه يكفي في اُصوليّة القاعدة استنباط الحكم الكلّيّ الإلهيّ منها ولو من دون تنجيز أو تعذير، وقاعدة ( الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، أو لا يقتضي ) قاعدة يستنبط منها حرمة الضدّ أو عدم حرمته، وهي حكم كلّيّ إلهيّ. أو يقال: يكفي في اُصوليّتها انتاجها على بعض المبانيّ، وهذه القاعدة تنتج على مبنى تخيّل أنّ النهي الغيريّ ينجّز ويعذّر.
الأحكام، ولكن يبقى معنىً لقولنا: ( الصعيد بمعنى وجه الأرض ) أو ( زرارة ثقة )(۱).
ثُمّ إنّه قد يقال: إنّ هذا التعريف لا يشمل مثل بحث المفاهيم، أو المطلق والمقيّد، أو العموم والخصوص، لكنّه هو(قدس سره) تعرّض في المقالات لدفع هذا التوهّم ببيان: أنّ هذه الأبحاث تتعرّض لكيفيّة تعلّق الحكم بالموضوع(۲)، وفرّق بين هذه الأبحاث وبحث المشتقّ، حيث إنّ بحث المشتقّ لا يندرج تحت التعريف، ولذا لا يكون من الأبحاث الاُصوليّة(۳)، وحيث إنّ عبارته في المقالات مغلقة فكأنّ بعضهم لم يلتفت إلى المقصود، ولهذا أشكل عليه بأنّنا لم نفهم الفرق بين هذه الأبحاث وبحث المشتقّ الذي هو خارج عن علم الاُصول، فإنّ بحث المشتقّ أيضاً يتكلّم عن حدود الموضوع هل هو خصوص المتلبس فعلاً بالمبدأ أو أعمّ من ذلك مثلاً؟ وتوضيح مقصوده(قدس سره) هو: أنّ القاعدة الاُصوليّة حينما يكون لها تأثير في الحكم تكون متعرّضة بالمباشرة للحكم أو لخصوصيّة في الحكم، ومبحث دلالة الشرط على المفهوم مثلاً يكون له تأثير في الحكم حينما يكون الجزاء حكماً من الأحكام، وتكون القاعدة حينئذ متعرّضة لخصوصيّة في الحكم؛ إذ تتعرّض لكون الجزاء ـ وهو الحكم حسب الفرض ـ مقيّداً بحدود دائرة الشرط، وأنّه ينتفي بانتفاء الشرط، وهذا بخلاف البحث عن معنىً أفراديّ ككلمة « الصعيد »، فإنّه لا يتكلّم عن خصوصيّة في الحكم، وإنّما يتكلّم عن المعنى الإفراديّ للصعيد الذي لا يكون حكماً في وقت من الأوقات وإن كان البحث عنه دخيلاً في استنباط الحكم أحياناً، وأيضاً بحث الإطلاق حينما يؤثّر في الحكم، أي: حينما يُجرى
(۱) المقالات، ج ۱، ص ٥٤، بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.
(۲) نفس المصدر والصفحة.
(۳) نفس المصدر، ص ٥٥.
الإطلاق في موضوع حكم من الأحكام يكون مفاده هو: أنّ الحكم ثابت على طبيعي الموضوع بلا قيد، وهذه خصوصيّة من خصوصيّات الحكم، وكذلك بحث العموم، حيث إنّ مفاده حينما يتعلّق الحكم بالعامّ هو أنّ الحكم ثابت لتمام أفراد العامّ. وتمام النكتة هو: أنّ هذه الأبحاث لا تتكلّم عن تفسير معنىً أفراديّ ككلمة « الصعيد » وإنّما تتكلّم عن سعة أو ضيق ونحو ذلك في معنىً تركيبيّ قد يكون ذلك المعنى حكماً من الأحكام، وأمّا بحث المشتقّ فهو وإن كان يتكلّم عن حدود الموضوع، لكنّه يتكلّم عن حدوده بما هو معنىً أفراديّ، لا عن حدوده بما هو موضوع حتّى يرجع إلى البحث عن خصوصيّة في الحكم وكيفيّة تعلّقه بموضوعه، ففرق كبير بينه وبين هذه الأبحاث.
نعم، يبقى شيء واحد وهو: أنّ تطبيق التعريف على بحث العموم كما صنعه المحقّق العراقيّ(قدس سره) مبنيّ على كون أداة العموم مفادها شمول الحكم واستيعابه لتمام أفراد الموضوع، فهو مشى هنا على هذا المبنى، في حين أنّ هذا المبنى ليس هو المبنى الصحيح، ولا هو مختاره في محلّه، والصحيح الذي هو مختاره في محلّه هو: أنّ أداة العموم تجمع أفراد مدخوله تحت المدخول، وتعطي معنىً شموليّاً أفراديّاً قبل فرض طروء الحكم على الموضوع، إذن فلا يكون العموم متعرّضاً بالمباشرة لخصوصيّة من خصوصيّات الحكم، كما لا يكون متعرّضاً للحكم(۱).
(۱) المحقّق العراقيّ(رحمه الله) يرى ـ حسب ما هو وارد في المقالات، ج ۱، المقالة الثلاثون، ص ٤۲۹ ـ ٤۳٠ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ ـ أنّ أداة العموم تفيد استيعاب أفراد المدخول، وأنّ البدليّة والشموليّة تكون نتيجة كون المدخول نكرة أو جنساً، وأنّ الاستغراقيّة والمجموعيّة في الجنس تكون بكيفيّة تعلّق الحكم بالأفراد من
 →
→
كونها بنحو قائم بكلّ واحد من المصاديق مستقلاّ أو قائم بالمجموع. إذن فمن حقّه أن يقول في المقام: إنّه في باب العموم نفهم خصوصيّة الحكم من الوضع التركيبيّ من الكلام، فينطبق التعريف على باب العموم كما هو منطبق على باب الإطلاق.
على أنّه يكفي إدخالا لبحث في علم الاُصول انطباق التعريف عليه بلحاظ بعض المباني، وعلى مبنى كون العموم يدلّ على شمول الحكم لتمام أفراد الموضوع يكون العموم مبيّناً لكيفيّة تعلّق الحكم بالأفراد، وهي الكيفيّة الشموليّة.
(۱) كأنّه(رحمه الله) عدل عن النقض بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» إلى هذا البيان حذراً عن أن يجاب بأنّ هذا ليس استدلالا على فقهيّ، وإنّما هذا هو الحكم الفقهيّ ابتداءً.
وهذه القاعدة شبيهة تماماً بما قاله بعضهم في علم الاُصول من أنّه إذا دلّ الأمر على وجوب شيء ثُمّ نسخ الوجوب بقي الجواز، بتقريب: أنّ الأمر يدلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ، وعلى كون ذلك الجواز في ضمن الوجوب، فإذا انتفى الوجوب بالنسخ بقي أصل الجواز ثابتاً على حاله. وكما أنّ هذه القاعدة تتعرّض بالمباشرة للحكم وهو الجواز، كذلك تلك القاعدة الفقهيّة تتعرّض بالمباشرة للحكم وهو الضمان.
۲ ـ يقال في فقه الطهارة: إنّه حينما يدلّ دليل على مطهّريّة شيء فهو يدلّ بالملازمة على طهارة ذلك الشيء، ولهذا قالوا: إنّ ما دلّ من الكتاب على مطهّريّة الماء يدلّ أيضاً على طهارته، وهذه القاعدة شبيهة تماماً بما يقال في علم الاُصول من أنّ الأمر بالشيء يدلّ بالملازمة على وجوب مقدّمته، أو النهي عن ضدّه، وكما أنّ هذه القاعدة الاُصوليّة تدلّ بالمباشرة على الحكم ـ أي: ناظرة إلى الحكم ـ وهو وجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ ـ بناءً على أنّ وجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ يعتبر حكماً فقهيّاً ـ كذلك تلك القاعدة الفقهيّة تدلّ بالمباشرة على الحكم، وهو الطهارة. وثانياً: أنّه ذهب المشهور ـ في قاعدة «أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» ـ إلى أنّ الثمرة الفقهيّة لهذا البحث هي صحّة الضدّ العبادة وفسادها، ومبنيّاً على هذا الرأي المشهور نقول: إنّ هذه القاعدة لا تحمل الميزة التي يراها المحقّق العراقيّ(قدس سره) ميزاناً لكون المسألة اُصوليّة، وهي التعرّض للحكم بالمباشرة، فإنّ هذه القاعدة لا تتعرّض بالمباشرة لفساد العبادة أو صحّتها، وإنّما هذه القاعدة تتعرّض ( بناءً على الاقتضاء ) لإثبات النهي في العبادة، ثُمّ نرجع بعد ذلك إلى قاعدة «أنّ النهي في العبادة يقتضي البطلان»، فهذه القاعدة الثانية هي التي تتعرّض بالمباشرة للحكم، وهو البطلان. كما أنّ القاعدة الاُولى ـ بناءً على عدم الاقتضاء ـ إنّماتتعرّض بالمباشرة لعدم النهي عن الضدّ، ثُمّ نرجع إلى إطلاق حكم الضدّ ونثبت به صحّته، وليست القاعدة الاُولى متعرّضة بالمباشرة لصحّته.
وثالثاً: أنّ القواعد المنطقيّة للاستنتاج تحمل نفس الميزة التي يراها المحقّق العراقيّ(قدس سره) ميزاناً لكون المسألة اُصوليّة، فإنّه حينما تكون النتيجة حكماً شرعيّاً تكون تلك القاعدة متعرّضة بالمباشرة للحكم، وتوضيح ذلك: أنّ الفقيه حينما يقول مثلاً: ( هذا ما دلّ على وجوبه خبر الثقة، وكلّما دلّ على وجوبه خبر الثقة فهو واجب تعبّداً، فهذا واجب تعبّداً )، فالقاعدة المنطقيّة الدخيلة في هذا الاستنتاج هي قاعدة الشكل الأوّل من القياس، وهي: أنّه متى ما كان الأصغر داخلاً في الأوسط، والأوسط داخلاً في الأكبر، فالأصغر داخل في الأكبر، والأكبر ثابت للأصغر، إذن فهذه القاعدة تتعرّض بالمباشرة لثبوت الأكبر للأصغر، فحينما يكون الأكبر حكماً من الأحكام ـ كما في هذا المثال ـ فقد تعرّضت القاعدة بالمباشرة لثبوت الحكم على الأصغر. فهذه كلّها نقوض على تعريف المحقّق العراقيّ(قدس سره) نحتاج لدفعها إلى إبراز نكتة اُخرى، ومعه قد تغنينا تلك النكتة عن النكتة التي يتبنّاها المحقّق العراقيّ(رحمه الله). ورابعاً: أنّنا نسأل: ما هو المراد من كون القاعدة الاُصوليّة ناظرة إلى الحكم الشرعيّ؟ هل المراد من ذلك كون القاعدة ناظرة إلى دلالة لفظيّة على الحكم من قبيل قاعدة « أنّ الأمر يدلّ على الوجوب »، أو المراد منه هو مطلق كون المحمول في القاعدة حكماً من الأحكام عند تأثيرها في الاستنباط؟ فإن كان المقصود هو الأوّل، خرج من علم الاُصول ما يكون من قبيل أبحاث الملازمات، كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو حرمة ضدّه، فإنّها ليست دلالات لفظيّة، وإن كان المقصود هو الثاني دخل في علم الاُصول وثاقة الراوي، فإنّ معنى كونزرارة ثقة مثلاً هو: أنّ نقل زرارة له دلالة ظنّيّة على صحّة ما ينقله، وأنّه يصدق غالباً في نقله، فحينما يكون ما ينقله حكماً من الأحكام فوثاقته تدلّ على أنّه صادق في هذا الحكم بمقدار سبعين بالمائة مثلاً، فهذا من قبيل قولنا: إنّ الأمر ظاهر في الوجوب، أي: يكشف عن الوجوب بمقدار سبعين بالمائة مثلاً، فكما أنّ قاعدة « ظهور الأمر في الوجوب » قاعدة اُصوليّة كذلك قاعدة « أنّ زرارة يصدق غالباً في نقله » تكون قاعدة اُصوليّة. نعم، الصدق الغالبي لزرارة لا يكفي لإثبات الحكم ظاهراً على المكلّف ما لم تضمّ إليه قاعدة حجّيّة خبر الثقة، كما أنّ ظهور الأمر في الوجوب لا يكفي لإثبات الوجوب ظاهراً على المكلّف ما لم تضمّ إليه قاعدة حجّيّة الظهور.
بل بالإمكان أن يدّعى: أنّ علم الاُصول ـ بناءً على هذا التعريف ـ يتّسع بمقدار كلّ ما يوجد في العالَم من قواعد دخيلة في الاستنباط، فمثلاً بالإمكان صياغة قاعدة اُصوليّة توازي قاعدة دلالة الصعيد على التراب أو على وجه الأرض، وذلك بأن يقال: ( متى ما كان الصعيد موضوعاً لحكم ثبت ذلك الحكم على التراب أو على وجه الأرض ) وهذا معناه: أنّ الفرق بين القواعد اللغويّة، أو أيّ قاعدة اُخرى دخيلة في الاستنباط وبين القواعد الاُصوليّة إنّما هو فرق راجع إلى صياغة الكلام من دون وجود فارق جوهريّ، بينما ليس الأمر هكذا.التعريف المختار لعلم الاُصول:
وأمّا التعريف المختار لعلم الاُصول فهو أن يقال: إنّ علم الاُصول هو العلم بالقواعد المشتركة في القياس الاستدلاليّ الفقهيّ. وتوضيح ذلك: أنّ نسبة علم الاُصول إلى علم الفقه كنسبة علم المنطق إلى سائر العلوم، فعلم المنطق يتناولصور الاستدلال المشتركة بين العلوم، وعلم الاُصول يتناول صور الاستدلال المشتركة في الفقه، وبالتحليل ترجع القيود التي نأخذها في تعريف علم الاُصول إلى قيود ثلاثة:
القيد الأوّل: أنّ القواعد الاُصوليّة لا تؤخذ فيها مادّة معيّنة من موادّ الفقه، أعني: فعلاً معيناً من أفعال المكلّفين كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك(۱)، أي: أنّها تكون لا بشرط تجاه هذه الموادّ، كما أنّ القواعد المنطقيّة لا تُؤخذ فيها مادّة معيّنة من موادّ العلوم، فهي لا تتكلّم عن الموادّ الفيزيائيّة، ولا الأعداد الرياضيّة، ولا الأدوية الطبّيّة ولا غير ذلك، وإنّما تتناول صورة الاستدلال التي تسري في كلّ هذه العلوم. وبهذا القيد تخرج القواعد اللغويّة البحتة من قبيل دلالة كلمة « صعيد » على التراب أو مطلق وجه الأرض، فإنّها إنّما تفيد في استنباط حكم فعل مضاف إلى التراب أو وجه الأرض، ولا تكون لا بشرط من حيث خصوصيّة الأفعال، وتخرج مسائل علم الحديث، أعني: آحاد الروايات، فإنّ كلّ رواية منها تبيّن حكماً مختصّاً بفعل خاصّ من الأفعال، وتخرج أيضاً القواعد الاستدلاليّة الفقهيّة التي تكون من قبيل قاعدة: إنّ دليل صحّة البيع يدلّ على الضمان مثلاً، فإنّها مختصّة بمادّة معيّنة من الموادّ كمادّة البيع، كما أنّ القواعد الفقهيّة(۲) التي هي من
(۱) ما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث الاستصحاب من الدورة السابقة، أي: الدورة الاُولى أدقّ تعبيراً من التعبير الوارد هنا، وهو: أنّ موادّ الفقه التي لا تؤخذ في القواعد الاُصوليّة هي كلّ عنوان أوّليّ أو ثانويّ متعلق لحكم واقعيّ كالصعيد مثلا الذي هو عنوان أوّليّ، وكالضرر الذي هو عنوان ثانوي.
راجع كتابنا في تقرير أبحاثه(رحمه الله) الجزء الخامس من القسم الثاني، ص ۲٥ بحسب الطبعة الاُولى وفق مطبعة وتجليد إسماعيليان.
(۲) وهي خارجة بالقيد الثاني أيضاً.
صور الاستدلال المشتركة بين العلوم، وعلم الاُصول يتناول صور الاستدلال المشتركة في الفقه، وبالتحليل ترجع القيود التي نأخذها في تعريف علم الاُصول إلى قيود ثلاثة:
القيد الأوّل: أنّ القواعد الاُصوليّة لا تؤخذ فيها مادّة معيّنة من موادّ الفقه، أعني: فعلاً معيناً من أفعال المكلّفين كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك(۱)، أي: أنّها تكون لا بشرط تجاه هذه الموادّ، كما أنّ القواعد المنطقيّة لا تُؤخذ فيها مادّة معيّنة من موادّ العلوم، فهي لا تتكلّم عن الموادّ الفيزيائيّة، ولا الأعداد الرياضيّة، ولا الأدوية الطبّيّة ولا غير ذلك، وإنّما تتناول صورة الاستدلال التي تسري في كلّ هذه العلوم. وبهذا القيد تخرج القواعد اللغويّة البحتة من قبيل دلالة كلمة « صعيد » على التراب أو مطلق وجه الأرض، فإنّها إنّما تفيد في استنباط حكم فعل مضاف إلى التراب أو وجه الأرض، ولا تكون لا بشرط من حيث خصوصيّة الأفعال، وتخرج مسائل علم الحديث، أعني: آحاد الروايات، فإنّ كلّ رواية منها تبيّن حكماً مختصّاً بفعل خاصّ من الأفعال، وتخرج أيضاً القواعد الاستدلاليّة الفقهيّة التي تكون من قبيل قاعدة: إنّ دليل صحّة البيع يدلّ على الضمان مثلاً، فإنّها مختصّة بمادّة معيّنة من الموادّ كمادّة البيع، كما أنّ القواعد الفقهيّة(۲) التي هي من
(۱) ما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث الاستصحاب من الدورة السابقة، أي: الدورة الاُولى أدقّ تعبيراً من التعبير الوارد هنا، وهو: أنّ موادّ الفقه التي لا تؤخذ في القواعد الاُصوليّة هي كلّ عنوان أوّليّ أو ثانويّ متعلق لحكم واقعيّ كالصعيد مثلا الذي هو عنوان أوّليّ، وكالضرر الذي هو عنوان ثانوي.
راجع كتابنا في تقرير أبحاثه(رحمه الله) الجزء الخامس من القسم الثاني، ص ۲٥ بحسب الطبعة الاُولى وفق مطبعة وتجليد إسماعيليان.
(۲) وهي خارجة بالقيد الثاني أيضاً.
مضاف إلى فعل يكون فيه الصحيح والأعمّ.
ومن امتيازات تعريفنا على التعاريف الماضية أنّه كانت تُؤخذ في التعاريف الماضية قيود لإخراج ما ليس من القواعد الاُصوليّة، ولا مبرّر لتلك القيود عدا أنّ الاُصوليّين عملا قد أخرجوا تلك القواعد عن علم الاُصول من دون أن تبرز نكتة ثبوتيّة لهذا العمل، فيقال مثلاً: إنّ القاعدة الاُصوليّة هي التي تكفي وحدها في مقام الاستنباط، أو هي التي تكون ناظرة إلى الحكم. وقيد الوحدة أو قيد النظر إنّما هو قيد انتزع من الواقع الخارجيّ لعلم الاُصول المدوّن في الكتب من دون أن توجد نكتة من أوّل الأمر في جعل علم الاُصول هي خصوص القواعد التي تكفي وحدها في الاستنباط، أو خصوص القواعد التي تنظر إلى الحكم، فهذه القيود هي تصحّح عمل الاُصوليّين من دون أن توجّهها، ولكن التعريف الذي ذكرناه يصحّح عمل الاُصوليّين ويوجّهه في نفس الوقت؛ لأنّ جميع القيود المأخوذة فيه مشتملة على مناسبة ثبوتيّة ومبرّر واقعيّ لأخذها بعين الاعتبار في علم الاُصول، بحيث لو اُعطي بيدنا تدوين علم الاُصول وتأسيسه من أصله لما أسّسنا ودوّنّا إلاّ بنفس هذا الترتيب المشتمل على هذه القيود. فبالنسبة للقيد الأوّل وهو كون القاعدة لا بشرط من حيث الموادّ ترى المناسبة واضحة في أخذه بعين الاعتبار، فإنّ علم الاُصول نشأ في أحضان علم الفقه، وتولّد بعد علم الفقه تأريخيّاً تلبية للحاجات الفنّيّة لعلم الفقه، حيث إنّ علم الفقه احتاج في كثير من الأحيان إلى قواعد واستدلالات، وتلك القواعد والاستدلالات بعضها كانت مقيّدة بمادّة معيّنة من قبيل قاعدة ما يضمن المقيّدة بالعقود مثلاً، ومن الواضح: أنّ مثل هذه القاعدة يناسب ذكرها في مبحث تلك المادّة، وبعضها كانت عامّة وغير مقيّدة بمادّة دون مادّة، فكان من المناسبأفرادها بالبحث، فاُفردت تلك القواعد بالبحث، وسمّيت بعلم الاُصول.
القيد الثاني: أن تكون تلك القاعدة: إمّا غير مقيّدة بحكم معيّن من قبيلحجّيّة خبر الثقة المنسجمة مع تمام الأحكام الفقهيّة، أو تكون مقيّدة بحكمسار في أبواب كثيرة من أبواب الفقه من قبيل دلالة الأمر على الوجوب، والنهي على الحرمة، واقتضاء النهي للفساد ونحو ذلك، فإنّ هذه القواعد وإن اختصّت بحكم معيّن من قبيل الوجوب أو الحرمة أو الفساد، إلاّ أنّ هذه الأحكام ـ كما ترى ـ سيّالة في سائر أبواب الفقه. وبهذا يخرج عن علم الاُصول ما كان من قبيل قاعدة ( أنّ ما دلّ على مطهّريّة شيء فقد دلّ على طهارته )، فإنّ هذه القاعدةوإن لم تكن مقيّدة بفعل من الأفعال، إلاّ أنّها مقيّدة بحكم معيّن غير سيّال في أبواب الفقه وهو الطهارة فمن الواضح: أنّ مثل هذه القاعدة يناسب ذكرها في ذلك الباب الفقهيّ المعيّن، لا إفرادها وجعلها في ضمن القواعد الاُصوليّة المستقلّة عن علم الفقه. القيد الثالث: أن تكون تلك القاعدة الداخلة في القياس الاستدلاليّ للفقه داخلة في القياس الأخير للاستنباط، وجميع القواعد الاُصوليّة من هذا القبيل، فمبحث الملازمات والامتناعات يدخل في القياس المباشر لاستنباط الحكم نفياً أو إثباتاً، وكذلك مباحث الحجج والاُصول، أو مباحث صغريات الظهور، غاية الأمر أنّ بعض هذه المباحث يدخل في كبرى القياس المباشر للاستنباط من قبيل حجّيّة خبر الثقة، فيقال مثلاً: هذا الحكم ما أخبر به الثقة، وكلّما أخبر به الثقة فهو ثابت تعبّداً، فهذا الحكم ثابت تعبّداً، وبعضها يدخل في صغرى القياس المباشر للاستنباط من قبيل مباحث صغريات الظهور، فيقال مثلاً: هذا الأمر ظاهر في الوجوب، والظهور يثبت الحكم تعبّداً، إذن فالوجوب ثابت تعبّداً.معيّنة ورد فيها ذلك الخبر، وكبراه داخلة في علم الاُصول(۱).

(۱) قد يقال ـ كما مضى في النقاش مع المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ـ: إنّه لا ينبغي أن يصاغ التعريف بصياغة تؤدّي إلى كون الفرق بين القواعد الاُصوليّة والقواعد الاُخرى الدخيلة في الاستنباط فرقاً في الصياغة، لا فرقاً جوهريّاً، بحيث كان بالإمكان تغيير صياغة تلك القواعد الاُخرى إلى ما يدخلها في علم الاُصول، فكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ خروج مسائل علم الرجال عن الاُصول أصبح أمراً صياغيّاً بحتاً، فلو بدّلنا صياغة المسألة الرجاليّة التي تقول: « زرارة ثقة » إلى قولنا: « كلّ خبر زرارة خبر ثقة » أصبحت هذه المسألة داخلة في علم الاُصول؛ إذ بالإمكان أن نشير إلى خبر من أخبار زرارة دالّ على أحد الأحكام ونقول: «هذا الخبر خبر ثقة، وخبر الثقة يثبت الحكم تعبّداً، إذن فهذا الحكم ثابت تعبّداً»، فقد أصبح كون خبر زرارة خبر ثقة صغرى في القياس المباشر للاستنباط، وهذا سنخ ما مضى من اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في مقام توضيح كون دلالة الأمر على الوجوب مسألة اُصوليّة من أنّنا نقول: «هذا الأمر ظاهر في الوجوب، والظهور يثبت الحكم تعبّداً، إذن فالوجوب ثابت تعبّداً».
فإن قلت: إنّ قولك: «هذا الخبر خبر ثقة» خاصّ بمادّة من الموادّ، وهي الفعل الذي يحكي عنه هذا الخبر، فهذا خارج بالقيد الأوّل، قلنا: كذلك قولك: «هذا الأمر ظاهر في الوجوب» خاصّ بالفعل الذي اُمر به في هذا الأمر، فإن جعلنا وقوع تطبيق من تطبيقات « الأمر ظاهر في الوجوب » صغرى للقياس المباشر كافياً في صدق عنوان: أنّ ظهور الأمر في الوجوب الذي لا يختصّ بمادّة من الموادّ وقع صغرى للقياس المباشر، فلنقل كذلك في المقام: إنّ وقوع تطبيق من تطبيقات « كلّ خبر زرارة خبر ثقة » صغرى للقياس المباشر كاف في صدق عنوان: أنّ كون خبر زرارة خبر ثقة الذي لا يختصّ بمادّة من الموادّ وقع صغرى للقياس المباشر.
ويمكن الجواب على هذا الإشكال بأن يقال: إنّ قولنا: «هذا الخبر خبر ثقة» وإن كان تطبيقاً لقولنا: «كلّ خبر زرارة خبر ثقة»، كما أنّ قولنا: «هذا الأمر ظاهر في الوجوب» تطبيق لقولنا: «الأمر ظاهر في الوجوب»، ولكن يوجد فرق جوهريّ بين التطبيقين، وهو:
أنّ التطبيق في الثاني يكون بمعنى العينيّة بين القضيّتين موضوعاً ومحمولاً، وأنّه لا فرق بينهما إلاّ في الكلّيّة والجزئيّة، وأمّا التطبيق في الأوّل فليس بهذا المعنى، وإنّما هو بمعنى الملازمة، أي: أنّ هذا الخبر مضاف إلى زرارة والوثاقة أيضاً مضافة إلى زرارة، فأصبح المضافان متلاقيين بلحاظ وحدة المضاف إليه، فصار هذا الخبر خبر ثقة، وبكلمة اُخرى: أنّ وثاقة زرارة حيثيّة تعليليّة لكون هذا الخبر خبر ثقة، ولكن ظهور الأمر في الوجوب هو عين ظهور هذا الأمر في الوجوب عينيّة الكلّيّ للمصداق، وليس مجرّد حيثيّة تعليليّة.
نعم، ذات كون هذا الخبر خبر ثقة قد أصبح دخيلاً في القياس المباشر، لكنّ هذا لا يشفع لا لكون ذلك داخلاً في علم الاُصول، ولا لكون قولنا: «كلّ خبر زرارة خبر ثقة» أو قولنا: «زرارة ثقة» داخلاً في علم الاُصول. أمّا الأوّل فلخروجه بالقيد الأوّل؛ لأنّه مختصّ بمادّة الفعل الذي يحكي ذاك الخبر عن حكمه، وأمّا الثاني فلأنّه ليس إلاّ حيثيّة تعليليّة لما دخل في القياس المباشر، لا عينيّة من باب العينيّة الثابتة بين الكلّيّ والمصداق.
ولكنّ الصحيح: أنّنا لو قسنا جملة « هذا الخبر خبر ثقة » إلى جملة « زرارة ثقة » صحّ القول بأنّ صدق الجملة الثانية مجرّد حيثيّة تعليليّة لصدق الجملة الاُولى من دون أن تكون منطبقة عليها انطباق الكلّيّ على المصداق، ولكنّنا لو قسناها إلى جملة « خبر زرارة خبر ثقة » فهذه الجملة عين الجملة الاُولى عينيّة الكلّيّ والمصداق وليست مجرّد حيثيّة تعليليّة لها، فصحيح: أنّنا حينما نجعل الوثاقة صفة لزرارة فارتباطها بهذا الخبر الذي هو خبر زرارة يكون بواسطة اتحاد طرف النسبتين، وهو زرارة، ويكون هذا حيثيّة تعليليّة لتوصيف هذا الخبر بالوثاقة من دون عينيّة بين الجملتين من سنخ عينيّة القضيّة الكلّيّة والقضيّة الجزئيّة التي تكون مصداقاً لها، ولكن حينما نصف خبر زرارة بكونه خبر ثقة، فانطباق هذا الوصف على هذا الخبر الجزئيّ إنّما يكون لأجل كون هذا الخبر مصداقاً لموصوف هذا الوصف، ومتّحداً معه اتّحاد المصداق مع الكلّيّ، وذلك تماماً من قبيل اتّحاد
هذا الأمر مع كلّيّ الأمر الذي وصف بأنّه ظاهر في الوجوب، وهذا معنى ما قلناه من أنّه رجع إذن الفرق بين القواعد الاُصوليّة ومسائل علم الرجال إلى الفرق في الصياغة، فلو صغنا المسألة بصياغة « زرارة ثقة » لم تدخل في علم الاُصول، ولو صغناها بصياغة « خبر زرارة خبر ثقة » دخلت في علم الاُصول.
وقد يقال: إنّ نكتة دخول مسألة من المسائل في علم من العلوم يجب أن تكون ثابتة في كلّ مسائل ذاك العلم، وإلاّ لجاز إدخال كلّ مسألة في ذاك العلم، ولكن لا يجب عدم انطباقها على مسائل علم آخر؛ وذلك لأنّه قد تكون مسائل العلم الآخر رغم اشتمالها على نفس النكتة اُفردت بعلم آخر على أساس جامع آخر مهمّ وواسع المصاديق غير موجود في باقي مسائل العلم الأوّل، فاقتضت المناسبة الذوقيّة جمع تلك المصاديق تحت ذاك الجامع الآخر، وأفرادها عن باقي مسائل العلم الأوّل، وإخراجها عن ذاك العلم، والمسائل الرجاليّة بالقياس إلى المسائل الاُصوليّة من هذا القبيل، فهي يجمعها البحث عن أحوال الرجال، وهو بحث واسع الانطباق على المسائل الكثيرة متميّز عن باقي مسائل علم الاُصول ممّا أوجب اقتضاء المناسبة أفرادها في تصنيف العلوم، فلا محيص عن أن يضاف إلى تعريف ذاك العلم قيد الخروج عن القاسم المشترك الموجود في العلم الآخر.
هذا، ولاُستاذنا الشهيد(قدس سره) بيان آخر لإخراج مسائل علم الرجال غير ما ذكره هنا، وهو ما تعرّض له في أوّل بحث خبر الواحد، ونحن قد حذفناه في تقريرنا المطبوع من هناك ونذكره هنا، وهو: أنّ علم الاُصول وإن كان علماً بالقواعد الفارغة عن الموادّ الفقهيّة، والتي هي موجّهة عامّة صوريّة بحت لعمليّة الاستنباط، ومسائل علم الرجال تحمل هذه الصفة، ولكنّها مع ذلك خارجة عن علم الاُصول، فإنّ ما يبحث عنه فيه إنّما هي الموجّهات الصوريّة التي ترجع إلى الشارع، أي: تكون شأناً من شؤون الشارع: إمّا بأن يكون حكماً مجعولاً للشارع كالحكم بحجّيّة خبر الواحد؛ إذ هو حكم مجعول له تأسيساً أو إمضاءً،
هذا الأمر مع كلّيّ الأمر الذي وصف بأنّه ظاهر في الوجوب، وهذا معنى ما قلناه من أنّه رجع إذن الفرق بين القواعد الاُصوليّة ومسائل علم الرجال إلى الفرق في الصياغة، فلو صغنا المسألة بصياغة « زرارة ثقة » لم تدخل في علم الاُصول، ولو صغناها بصياغة « خبر زرارة خبر ثقة » دخلت في علم الاُصول.
وقد يقال: إنّ نكتة دخول مسألة من المسائل في علم من العلوم يجب أن تكون ثابتة في كلّ مسائل ذاك العلم، وإلاّ لجاز إدخال كلّ مسألة في ذاك العلم، ولكن لا يجب عدم انطباقها على مسائل علم آخر؛ وذلك لأنّه قد تكون مسائل العلم الآخر رغم اشتمالها على نفس النكتة اُفردت بعلم آخر على أساس جامع آخر مهمّ وواسع المصاديق غير موجود في باقي مسائل العلم الأوّل، فاقتضت المناسبة الذوقيّة جمع تلك المصاديق تحت ذاك الجامع الآخر، وأفرادها عن باقي مسائل العلم الأوّل، وإخراجها عن ذاك العلم، والمسائل الرجاليّة بالقياس إلى المسائل الاُصوليّة من هذا القبيل، فهي يجمعها البحث عن أحوال الرجال، وهو بحث واسع الانطباق على المسائل الكثيرة متميّز عن باقي مسائل علم الاُصول ممّا أوجب اقتضاء المناسبة أفرادها في تصنيف العلوم، فلا محيص عن أن يضاف إلى تعريف ذاك العلم قيد الخروج عن القاسم المشترك الموجود في العلم الآخر.
هذا، ولاُستاذنا الشهيد(قدس سره) بيان آخر لإخراج مسائل علم الرجال غير ما ذكره هنا، وهو ما تعرّض له في أوّل بحث خبر الواحد، ونحن قد حذفناه في تقريرنا المطبوع من هناك ونذكره هنا، وهو: أنّ علم الاُصول وإن كان علماً بالقواعد الفارغة عن الموادّ الفقهيّة، والتي هي موجّهة عامّة صوريّة بحت لعمليّة الاستنباط، ومسائل علم الرجال تحمل هذه الصفة، ولكنّها مع ذلك خارجة عن علم الاُصول، فإنّ ما يبحث عنه فيه إنّما هي الموجّهات الصوريّة التي ترجع إلى الشارع، أي: تكون شأناً من شؤون الشارع: إمّا بأن يكون حكماً مجعولاً للشارع كالحكم بحجّيّة خبر الواحد؛ إذ هو حكم مجعول له تأسيساً أو إمضاءً،
 →
→
فلا تصبح منطقاً لعلم الفقه، ولا تكون وسيعة بنحو تكون منطقاً لعلوم اُخرى أيضاً، بل اُخذت فيها الموادّ بدرجة سقطت عن قابليّة كونها منطقاً لسائر العلوم، ولكنّها منطق لعلم الفقه ودخيلة في الاستنباط من دون شرط وقوعها كبرى في طريق الاستنباط، والبحث عن وثاقة الراوي وإن كان أيضاً دخيلاً في الاستنباط، ولكن هنا قيد آخر ثابت بالارتكاز المميّز بين علم الاُصول ومثل علم الرجال، وهو: أنّ علم الاُصول يجب أن يكون مربوطاً بالحكم، بمعنى أن يكون هو حكماً ظاهريّاً كحجّيّة خبر الثقة، أو يكون من مقتضيات الحكم في إحدى المراحل الثلاث: الجعل، والإبراز، والتنجيز أو التعذير، فالأوّل كمباحث إمكان الترتّب، والملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها، ونحو ذلك من الاُمور التي يقتضيها الحكم بحسب عالم جعله، والثاني كمباحث دلالة الأمر على الوجوب، والنهي على الحرمة، والمشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ أو المتلبّس، ونحو ذلك، والثالث كمباحث منجّزيّة الاحتمال أو معذّريّته عقلاً.
أقول بمناسبة ذكره(رحمه الله) للمشتقّ: وقد يفترض أنّ بحث المشتقّ أو نحوه كبحث الصحيح والأعمّ داخل في بحث الاُصول بخلاف البحث عن معنى مثل كلمة « الصعيد » هل هو التراب أو مطلق ما على وجه الأرض مثلا، والفرق: أنّ القيد في بحثي المشتقّ والصحيح والأعمّ لم يخرجهما عن سريانهما في الاستنباط في كثير من أبواب الفقه، ولكن القيد في مثل تفسير كلمة « الصعيد » أخرجه عن الدخل في الاستنباط في عامّة أبواب الفقه، وخصّه بمسألة التيمّم.
موضوع علم الاُصول
الجهة الثانية ـ في موضوع علم الاُصول:
وقد قدّم له الأصحاب اُموراً، وبحثوا فيها عن أشياء مأخوذة على ما يقولون من الحكماء والفلاسفة، في حين أنّه لا يوجد لبعض ما ذكروها عين ولا أثر في كلمات الحكماء والفلاسفة. ونحن أيضاً هنا ـ تبعاً لهم ـ نتكلّم عن اُمور ثلاثة إجابةً لطلب بعض الأحبّة وإن كنّا نرى أنّه لا جدوى في تلك الأبحاث: الأوّل: أنّ لكلّ علم موضوعاً. والثاني: أنّ العلم يبحث عن العوارض الذاتيّة للموضوع. والثالث: معنى العوارض الذاتيّة.هل إنّ لكلّ علم موضوعاً؟
الأوّل: هل يجب أن يمتاز كلّ علم بموضوع معيّن، أو لا؟ فقد قيل: نعم، لابدّ لكلّ علم من موضوع، وقد يبرهن على ذلك. وفي مقابل ذلك تارةً يقال: لا برهانعلى ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم، واُخرى يقال: إنّ هناك برهاناً على خلاف ذلك:
فنحن هنا تارة نتكلّم حول البرهان على ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم، واُخرى حول البرهان على عدم ضرورة ذلك. أمّا الكلام الأوّل، وهو: أنّه هل هناك برهان على ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم أو لا؟ فقد بُرهن على ذلك بمجموع مقدّمتين: الاُولى: القاعدة الفلسفيّة القائِلة: ( إنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد ) بعد الإيمان بأنّها كما تصدق في الواحد بالشخص فهو لا يصدر إلاّ من واحد بالشخص، كذلك تصدق في الواحد بالنوع، فهو لا يصدر إلاّ من الواحد بالنوع. الثانية: أنّ كلّ علم يترتّب على جميع مسائله غرض واحد بالنوع. إذن فيكشف هذا الغرض الواحد المترتّب على المسائل المتشتّتة عن وجود جامع حقيقيّ بينها، وهو موضوع العلم. وتحقيق الكلام في المقدّمة الثانية هو: أنّه لا ينبغي أن يكون المراد من الغرض الواحد المترتّب على مسائل العلم هو الغرض في مرتبة التدوين والدرس؛ إذ من الواضح: أنّ الأغراض تختلف في ذلك باختلاف الناس، فقد نرى شخصاً لم يتعلّق غرض له بتدوين أو درس علم معيّن إلاّ بمقدار قليل منه، وقد نرى شخصاً تعلّق غرضه بأكثر من ذلك، وشخصاً آخر تعلّق غرضه بتمام العلم، وقد يكون الغرض سنخ غرض لا يتحقّق إلاّ بدراسة علوم عديدة من قبيل غرض تحصيل الاجتهاد مثلاً، فليس هناك غرض واحد مشترك بين تمام مسائل العلم حتّى يكشف عن وحدة الموضوع. فلا بدّ أن يكون المراد من الغرض هو الأثر المترتّب على ذات العلم الثابت فيعلى ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم، واُخرى يقال: إنّ هناك برهاناً على خلاف ذلك:
فنحن هنا تارة نتكلّم حول البرهان على ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم، واُخرى حول البرهان على عدم ضرورة ذلك. أمّا الكلام الأوّل، وهو: أنّه هل هناك برهان على ضرورة وجود موضوع معيّن لكلّ علم أو لا؟ فقد بُرهن على ذلك بمجموع مقدّمتين: الاُولى: القاعدة الفلسفيّة القائِلة: ( إنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد ) بعد الإيمان بأنّها كما تصدق في الواحد بالشخص فهو لا يصدر إلاّ من واحد بالشخص، كذلك تصدق في الواحد بالنوع، فهو لا يصدر إلاّ من الواحد بالنوع. الثانية: أنّ كلّ علم يترتّب على جميع مسائله غرض واحد بالنوع. إذن فيكشف هذا الغرض الواحد المترتّب على المسائل المتشتّتة عن وجود جامع حقيقيّ بينها، وهو موضوع العلم. وتحقيق الكلام في المقدّمة الثانية هو: أنّه لا ينبغي أن يكون المراد من الغرض الواحد المترتّب على مسائل العلم هو الغرض في مرتبة التدوين والدرس؛ إذ من الواضح: أنّ الأغراض تختلف في ذلك باختلاف الناس، فقد نرى شخصاً لم يتعلّق غرض له بتدوين أو درس علم معيّن إلاّ بمقدار قليل منه، وقد نرى شخصاً تعلّق غرضه بأكثر من ذلك، وشخصاً آخر تعلّق غرضه بتمام العلم، وقد يكون الغرض سنخ غرض لا يتحقّق إلاّ بدراسة علوم عديدة من قبيل غرض تحصيل الاجتهاد مثلاً، فليس هناك غرض واحد مشترك بين تمام مسائل العلم حتّى يكشف عن وحدة الموضوع. فلا بدّ أن يكون المراد من الغرض هو الأثر المترتّب على ذات العلم الثابت فيوجود الجامع بين مسائل العلم فقد فرغنا عن وحدة الموضوع قبل هذا البرهان، ولو فرضنا التباين في الموضوعات والمحمولات كانت النِسب لا محالة متباينة.
وهناك برهان آخر على أنّ لكلّ علم موضوعاً واحداً، وهو: أنّ تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات، فلابدّ أن يكون لكلّ علم موضوع على حدة لا محالة. وقد أورد صاحب الكفاية(قدس سره) على القول بكون تمايز العلوم بالموضوعات: أنّه لو كان تعدّد الموضوع هو الذي يعدّد العلوم لكان كلّ باب، بل كلّ مسألة علماً على حدة(۱). إلاّ أنّ هذا الإشكال بالإمكان دفعه؛ لأنّهم يقولون: إنّ موضوع العلم هو الذي يبحث عن عوارضه الذاتيّة، ويقولون: إنّ العارض الذاتيّ لشيء إذا كان عارضاً ذاتيّاً لما هو أعمّ منه كان موضوع العلم هو ذاك الشيء الأعمّ، إذن فبالإمكان أن يقال ـ حسب وجهة نظرهم ـ: إنّ موضوع العلم الذي يمتاز به العلوم هو ذاك الشيء الذي تعرض عليه العوارض الذاتيّة الموجودة في ذلك العلم من دون أن تعرض على ما هو أعمّ منه. ولكنّ أصل هذا البرهان على وحدة الموضوع لكلّ علم في غير محلّه، فإنّنا إنّما نؤمن بكون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لو آمنّا منذ البدء بأنّ لكلّ علم موضوعاً واحداً، وإلاّ فكون تمايزها بتمايز الموضوعات أوّل الكلام. نعم، لو فرض ورود دليل تعبّديّ من آية أو رواية على أنّ تمايز العلوم بالموضوعات لكشفنا بنحو الإنّ عن أنّ كلّ علم له موضوع واحد.
(۱) راجع الكفاية، ج ۱، ص ٥۳ بحسب الطبعة المحقّقة بتحقيق الشيخ سامي الخفاجيّ حفظه الله.

(۱) راجع محاضرات الفيّاض، ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص ۱۷.
(۲) على أنّه لو كانت المحمولات اعتباريّة فليكن الجامع بينها أيضاً اعتباريّاً، ويكفينا الجامع الحقيقيّ بين الموضوعات.
بين الوجود والعدم؟(۱).
ويرد عليه: أنّ مقصود الفلاسفة من فرض موضوع للعلم ليس هو خصوص ما يكون جامعاً بين موضوعات المسائل حسب صياغاتها اللفظيّة، ونفس هؤلاء المستشكلين قد اعترفوا بصحّة دعوى وجود الموضوع بالنسبة إلى خصوص الفلسفة العالية، وقالوا: إنّ موضوعها هو الوجود، في حين أنّ الوجود في مسائل الفلسفة العالية حسب صياغتها اللفظيّة يكون محمولاً، فيقال مثلاً: الجوهر موجود، العرض موجود، النفس موجودة، الواجب موجود، العقل موجود، الفلك موجود... وهكذا. فالمقصود من ثبوت الموضوع الواحد للعلم هو وجود نقطة محوريّة تدور حولها مسائل العلم وإن فرض أنّ تلك النقطة المحوريّة وقعت محمولاً في المسائل حسب مناسبات صياغة اللفظ، فكأنّما ترجع مسائل الفلسفة ـ لو أردنا أن نجعل الوجود موضوعاً ـ إلى قولنا: الوجود متعيّن بوجود جوهريّ، أو الوجود متعيّن بوجود عرضيّ، وهكذا، لكن مناسبات صياغة الكلام اقتضت أن نقول: الجوهر موجود، العرض موجود... إلى آخره. فليكن موضوع علم الفقه أيضاً هو الحكم وإن كان يقع الحكم محمولاً في المسائل بحسب الصياغة اللفظيّة، حيث يقال: الدم نجس، والخمر حرام، والصلاة واجبة... ونحو ذلك، فكأنّها ترجع إلى قولنا: الحكم متعيّن ومتحصّص بحصّة نجاسة الدم، أو حرمة الخمر، أو وجوب الصلاة... وهكذا، وكما يقال: إنّ موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين مع أنّ الدم في قولنا: الدم نجس، ونحو ذلك ليس فعلاً من أفعال المكلّفين، وإنّما من الأعيان الخارجيّة.
(۱) راجع أجود التقريرات، ج ۱ المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، ص ٤، تحت الخط، ومحاضرات الفيّاض، ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئيّ، ص ۱۸.

(۱) أي: الأثر المترتّب على ذات العلم الثابت في وعائه المناسب له.
البحث عن الأسباب القصوى للوجود ». فليكن بعض العلوم يبحث عنأسباب الغرض، وليكن الغرض هو الموضوع والمحور، كما أنّ علم الطبّ يبحث عن الصحّة وعللها وموانعها وقواطعها، فليكن موضوع علم الطبّ هو الصحّةمثلاً.
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل، وهو: أنّ كلّ علم له موضوع واحد. بقي الكلام في الأمر الثاني، وهو: أنّ كلّ علم يبحث عن العوارض الذاتيّة لموضوعه، وفي الأمر الثالث وهو تفسير العوارض الذاتيّة. ولعلّ المعروف بين المتقدّمين في تفسير العوارض الذاتيّة هو: أنّ ما يعرض بلا واسطة، أو بواسطة أمر مساو داخلي وهو الفصل، أو مساو خارجيّ فهو عارض ذاتيّ، وما يعرض بواسطة أمر أخصّ، أو أعمّ داخليّ وهو الجنس، أو أعمّ خارجيّ، أو بواسطة أمر مباين فهو عارض غريب. وقد وقعت المناقشة في مجموع هذين الأمرين حول ثلاث نقاط: ۱ ـ هل العارض الذاتيّ معناه هو هذا الذي ذكر، أو شيء آخر؟ ۲ ـ هل إنّ العلم بحثه يقتصر على العارض الذاتيّ للموضوع، وإنّه ليس من حقّه البحث عن العارض الغريب، أو لا؟ ۳ ـ كيف يمكن تطبيق ذلك على سائر العلوم؟معنى العارض الذاتيّ:
أمّا النقطة الاُولى: وهي أنّه هل من الصحيح ما ذكر في تعريف العارض الذاتيّ، أو لا؟ فقد ناقش في ذلك المحقّق العراقيّ(قدس سره) وغيره، إلاّ أنّنا نقتصر على ذكر كلام المحقّق العراقيّ(قدس سره)(۱) الذي هو ألطف ما اُفيد في المقام، ثُمّ نناقشه، فنقول: قد أفاد المحقّق العراقيّ في المقام: أنّ العرض: إمّا ذاتيّ بمعنى الذاتيّ المذكور في كتاب الكلّيّات، أي: الجنس أو الفصل أو النوع(۲)، أو خارج لازم لا يحتاج إلى سبب كالحرارة بالنسبة إلى النار، أو خارج يحتاج إلى واسطة. وعلى الثالث: فإمّا أن تكون تلك الواسطة حيثيّة تعليليّة، أي: ليست هي المعروضة للعرض، وإنّما هي علّة لعروض العرض(۳) على المعروض، أو حيثيّة تقييديّة، أي: أنّها هي المعروضة حقيقة للعرض. فالأقسام الثلاثة الاُولى ينبغي الاعتراف بذاتيّتها؛ إذ هي تعرض على الموضوع حقيقة، أمّا الأوّل فهو ثابت للشيء بأعلى مراتب الثبوت، فإنّه من ذاتيّاته، وأمّا الثاني فهو ثابت للشيء لازم له، ولا واسطة بينه وبين المعروض، وأمّا الثالث فأيضاً هو عارض حقيقة على الشيء؛ لأنّ الواسطة إنّما هي واسطة تعليليّة، ولا يفرّق في ذلك بين ما ذكروه من أقسام الواسطة من كونها مبايناً أو أخصّ أو مساوياً داخليّاً أو خارجيّاً أو أعمّ داخليّاً أو خارجيّاً،
(۱) راجع المقالات، ج ۱، ص ٥ ـ ۷ بحسب طبعة المطبعة العلميّة في النجف الأشرف. أمّا بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم فراجع: ج ۱، ص ۳۹ ـ ٤۷، ونهاية الأفكار، ج ۱، ص ۱۳ ـ ۱۷.
(۲) إن أخذنا بحاقّ المصطلح الوارد في كتاب الكلّيّات، فالمقصود هنا أوسع من ذلك؛ حيث يشمل ذاتيّات غير الجنس والفصل والنوع، كما مثّل له المحقّق العراقيّ(رحمه الله)بالأبيضيّة والموجوديّة المنتزعتين من البياض والوجود.
والخلاصة: أنّ المقياس هو كون العرض منتزعاً من مقام ذات الشيء، سواء كان ذلك الشيء جنساً أو فصلا أو نوعاً، أو لم يكن كذلك.
(۳) كالمجاورة للنار الموجبة لعروض الحرارة على الماء. راجع نهاية الأفكار، ج ۱، ص ۱۳، والمقالات، ج ۱، ص ٤٠ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.
المحقّق العراقيّ(قدس سره)(۱) الذي هو ألطف ما اُفيد في المقام، ثُمّ نناقشه، فنقول:
قد أفاد المحقّق العراقيّ في المقام: أنّ العرض: إمّا ذاتيّ بمعنى الذاتيّ المذكور في كتاب الكلّيّات، أي: الجنس أو الفصل أو النوع(۲)، أو خارج لازم لا يحتاج إلى سبب كالحرارة بالنسبة إلى النار، أو خارج يحتاج إلى واسطة. وعلى الثالث: فإمّا أن تكون تلك الواسطة حيثيّة تعليليّة، أي: ليست هي المعروضة للعرض، وإنّما هي علّة لعروض العرض(۳) على المعروض، أو حيثيّة تقييديّة، أي: أنّها هي المعروضة حقيقة للعرض. فالأقسام الثلاثة الاُولى ينبغي الاعتراف بذاتيّتها؛ إذ هي تعرض على الموضوع حقيقة، أمّا الأوّل فهو ثابت للشيء بأعلى مراتب الثبوت، فإنّه من ذاتيّاته، وأمّا الثاني فهو ثابت للشيء لازم له، ولا واسطة بينه وبين المعروض، وأمّا الثالث فأيضاً هو عارض حقيقة على الشيء؛ لأنّ الواسطة إنّما هي واسطة تعليليّة، ولا يفرّق في ذلك بين ما ذكروه من أقسام الواسطة من كونها مبايناً أو أخصّ أو مساوياً داخليّاً أو خارجيّاً أو أعمّ داخليّاً أو خارجيّاً،
(۱) راجع المقالات، ج ۱، ص ٥ ـ ۷ بحسب طبعة المطبعة العلميّة في النجف الأشرف. أمّا بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم فراجع: ج ۱، ص ۳۹ ـ ٤۷، ونهاية الأفكار، ج ۱، ص ۱۳ ـ ۱۷.
(۲) إن أخذنا بحاقّ المصطلح الوارد في كتاب الكلّيّات، فالمقصود هنا أوسع من ذلك؛ حيث يشمل ذاتيّات غير الجنس والفصل والنوع، كما مثّل له المحقّق العراقيّ(رحمه الله)بالأبيضيّة والموجوديّة المنتزعتين من البياض والوجود.
والخلاصة: أنّ المقياس هو كون العرض منتزعاً من مقام ذات الشيء، سواء كان ذلك الشيء جنساً أو فصلا أو نوعاً، أو لم يكن كذلك.
(۳) كالمجاورة للنار الموجبة لعروض الحرارة على الماء. راجع نهاية الأفكار، ج ۱، ص ۱۳، والمقالات، ج ۱، ص ٤٠ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.
هو الاتّحاد في الوجود، وهذا ثابت فيما عدا الأخير، وبلحاظ العروض تكون الأقسام الثلاثة الأخيرة عوارض غريبة(۱)؛ لأنّها في الحقيقة عرضت على الواسطة التي هي حيثيّة تقييديّة، كما أنّ الأقسام الثلاثة الاُولى كانت عوارض ذاتيّة، وأمّا الرابع وهو عروض العارض على الجنس بواسطة النوع فهذا عروض ضمنيّ للعرض على الشيء؛ لأنّ الجنس موجود في ضمن النوع فما يعرض على النوع يكون عارضاً ضمناً على الجنس، فإن قلنا بكفاية العروض الضمنيّ في الذاتيّة كان هذا عارضاً ذاتيّاً، وإن قلنا باشتراط الاستقلاليّة في العروض كان هذا عارضاً غريباً.
ثُمّ استظهر(قدس سره) من كلمات الفلاسفة أنّ الملحوظ هو عالم العروض لا عالم الحمل، وأنّ العروض يجب أن يكون استقلاليّاً لا ضمنيّاً، إذن فالعرض الذاتيّ هو الأقسام الثلاثة الاُولى والباقي كلّه غريب حتّى القسم الرابع وهو ما يعرض على الجنس بواسطة النوع، وإلاّ للزم أن يبحث في علم الحيوان عن عوارض الإنسان، وفي علم الطبيعي الذي موضوعه الجسم عن الطبّ. وقد نقل المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخواجة نصير الدين الطوسيّ(قدس سره) في شرح الإشارات أنّه إذا كان عندنا موضوعان: أحدهما أخصّ والآخر أعمّ، فالبحث عن
(۱) وهذا الكلام لا ينطبق على القسم الأوّل من هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة، وهو عروض العرض على النوع بواسطة الجنس كعروض الألم على الإنسان بواسطة الروح الحيوانيّة؛ فإنّ الألم يعرض حقيقةً على الإنسان.
والواقع: أنّ الحقّ مع المحقّق العراقيّ(رحمه الله) الذي قلنا: إنّه حذف هذا القسم، فهو غير مذكور لا في المقالات ولا في نهاية الأفكار؛ وذلك لأنّ الروح الحيوانيّة حيثيّة تعليليّة لعروض الألم على الإنسان، وبكلمة اُخرى: إنّ عروض العرض على النوع بواسطة الجنس لا يعقل أن يكون إلاّ لكون الجنس حيثيّة تعليليّة، فيدخل ذلك في قسم الحيثيّة التعليليّة، ولا يوجد لدينا هذا القسم في فرض كون الواسطة حيثيّة تقييديّة.
هو الاتّحاد في الوجود، وهذا ثابت فيما عدا الأخير، وبلحاظ العروض تكون الأقسام الثلاثة الأخيرة عوارض غريبة(۱)؛ لأنّها في الحقيقة عرضت على الواسطة التي هي حيثيّة تقييديّة، كما أنّ الأقسام الثلاثة الاُولى كانت عوارض ذاتيّة، وأمّا الرابع وهو عروض العارض على الجنس بواسطة النوع فهذا عروض ضمنيّ للعرض على الشيء؛ لأنّ الجنس موجود في ضمن النوع فما يعرض على النوع يكون عارضاً ضمناً على الجنس، فإن قلنا بكفاية العروض الضمنيّ في الذاتيّة كان هذا عارضاً ذاتيّاً، وإن قلنا باشتراط الاستقلاليّة في العروض كان هذا عارضاً غريباً.
ثُمّ استظهر(قدس سره) من كلمات الفلاسفة أنّ الملحوظ هو عالم العروض لا عالم الحمل، وأنّ العروض يجب أن يكون استقلاليّاً لا ضمنيّاً، إذن فالعرض الذاتيّ هو الأقسام الثلاثة الاُولى والباقي كلّه غريب حتّى القسم الرابع وهو ما يعرض على الجنس بواسطة النوع، وإلاّ للزم أن يبحث في علم الحيوان عن عوارض الإنسان، وفي علم الطبيعي الذي موضوعه الجسم عن الطبّ. وقد نقل المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخواجة نصير الدين الطوسيّ(قدس سره) في شرح الإشارات أنّه إذا كان عندنا موضوعان: أحدهما أخصّ والآخر أعمّ، فالبحث عن
(۱) وهذا الكلام لا ينطبق على القسم الأوّل من هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة، وهو عروض العرض على النوع بواسطة الجنس كعروض الألم على الإنسان بواسطة الروح الحيوانيّة؛ فإنّ الألم يعرض حقيقةً على الإنسان.
والواقع: أنّ الحقّ مع المحقّق العراقيّ(رحمه الله) الذي قلنا: إنّه حذف هذا القسم، فهو غير مذكور لا في المقالات ولا في نهاية الأفكار؛ وذلك لأنّ الروح الحيوانيّة حيثيّة تعليليّة لعروض الألم على الإنسان، وبكلمة اُخرى: إنّ عروض العرض على النوع بواسطة الجنس لا يعقل أن يكون إلاّ لكون الجنس حيثيّة تعليليّة، فيدخل ذلك في قسم الحيثيّة التعليليّة، ولا يوجد لدينا هذا القسم في فرض كون الواسطة حيثيّة تقييديّة.
فإذا لاحظنا مرتبة الوجود الخارجيّ، فمتى ما صدق الحمل صدق العروض وبالعكس، فالأقسام الستّة(۱)، أعني: ما عدا القسم الأخير من الأقسام التي ذكرها المحقّق العراقيّ(قدس سره) يكون الحمل والعروض معاً فيها ذاتيّاً، فإدراك الكلّيّات إذا فرض عارضاً على النوع أو الفصل فهو محمول وعارض حقيقة على الجنس في مرتبة الوجود الخارجيّ، وأمّا إذا لاحظنا مرتبة التحليل فالجنس شيء والفصل شيء آخر مباين له، وفي تلك المرتبة عوارض الفصل وكذا النوع لا تحمل على الجنس وكذا العكس، فكما لم يصدق العروض لم يصدق الحمل، إذن فلو اُريد التفصيل وجب أن يفصل بين مرتبة الوجود ومرتبة التحليل، لا بين الحمل والعروض.
الإشكال الثالث الذي به تتّضح حقيقة الحال هو: أنّ مراد الحكماء من العرض الذاتيّ ليس هو الذاتيّ عروضاً أو حملاً بلحاظ مرتبة التحليل فقط، وإلاّ لكان عارض النوع غريباً عن الجنس، فإنّ ما يعرض على الكلّ بما هو كلّ ليس بحسب الدقّة عارضاً على جزئه التحليليّ بوجه من الوجوه، في حين نراهم يجعلون عارض النوع ذاتيّاً للجنس. وليس مرادهم أيضاً من العرض الذاتيّ الذاتيّة عروضاً أو حملاً بلحاظ مرتبة الوجود، فإنّهم اتّفقوا على أنّ العرض الذي يعرض على الشيء بواسطة أمر أعمّ خارجيّ أو بواسطة أمر أخصّ خارجيّ ليس ذاتيّاً، مع أنّه في مرتبة الوجود عارض ومحمول على ذلك الشيء. بل المراد من الذاتيّة هي الذاتيّة بلحاظ منشَأيّة موضوع المسألة لمحمولها. وتوضيح ذلك: أنّ موضوع المسألة يتصوّر له نسبتان إلى محمولها:
(۱) بل الخمسة؛ لما عرفت من أنّ الخامس ـ حسب ترتيب اُستاذنا(قدس سره) ـ لا وجود له، ولم يذكره المحقّق العراقىّ.

(۱) بل الستّة كما مضى.

(۱) بل الستّة كما مضى.

(۱) بل الستّة كما مضى.
الذاتيّ للشيء عرض ذاتيّ لذلك الشيء؛ لأنّ معلول المعلول معلول. وبهذا يعرف أيضاً أنّ عرض النوع ذاتيّ للجنس، فإنّه وإن كان النوع أخصّ من الجنس ولكن هذه الأخصّيّة إنّما هي بسبب الفصل الذي لا يسبِّب دخله في ثبوت العرض كون العرض غريباً على الجنس، وبهذا اتّضح السرّ فيما مضى عن شرح الإشارات من أنّ الخاصّ لو كانت نسبته إلى العامّ نسبة النوع إلى الجنس، فالبحث عن الخاصّ داخل في البحث عن العامّ وجزء منه، ولو كانت نسبته إليه نسبة المقيّد إلى المطلق، فالبحث عن الخاصّ ليس جزءاً من البحث عن العامّ.
وقد ظهر أيضاً بما ذكرناه الخلل فيما ذكره جملة من المحقّقين كالمحقّق الإصفهانيّ(قدس سره)(۱)، حيث قالوا في مقام بيان الضابط لذاتيّة العرض وعدم ذاتيّته حينما يكون عارضاً على الشيء بواسطة أخصّ: إنّه متى ما كانت الواسطة مع العرض مجعولين بجعل واحد كان العرض ذاتيّاً، ومتى ما كان كلّ منهما مجعولاً بجعل مستقلّ كان العرض غريباً، فمثلاً العوارض التي تعرض على الإنسان بواسطة كونه عراقيّاً من قبيل أمزجة خاصّة أو عادات خاصّة تكون عوارض غريبة للإنسان؛ لأنّها مجعولة بجعل مستقلّ غير جعل العراقيّة، ولكن الجسميّة العارضة على الوجود بواسطة كونه جوهراً عارض ذاتيّ للوجود؛ لأنّ الجسميّة مع الجوهريّة مجعولتان بجعل واحد. أقول: قد تمكن دعوى: أنّ اتّخاذ الواسطة مع العرض في الجعل يكون نكتة في كون العرض أوّليّاً، حيث إنّ الواسطة ليس لها جعل زائد على العرض، فكأنّما عرض العرض رأساً على الشيء بلا واسطة، ولكنّ العارض الذاتيّ أعمّ من
(۱) راجع نهاية الدراية، ج ۱، ص ۲۲ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.
العارض الأوّلي، ولا يشترط فيه عدم الواسطة، فإنّ الذاتيّة تكون بمعنى الذاتيّة المنشَأيّة بأن يكون المعروض منشأً لوجود العارض ولو بألف واسطة.
وعلى أيّ حال، فقد اتّضح بما ذكرناه: أنّ حمل الذاتيّة في كلمات الحكماء على الذاتيّة المنشَأيّة هو الذي يفسّر لنا مجموع هذه الاُمور الموجودة في كلماتهم.تنبيهات:
بقي التنبيه على عدّة اُمور: الأوّل: أنّ الاُصوليّين قد ذكروا في المقام العرض الذي يعرض بواسطة أمر مباين، وجعلوه عرضاً غريباً(۱)، وهذا القسم هو من إضافات علماء الاُصول، وليس موجوداً في التقسيم الأصليّ. وتوضيح النكتة في ذلك: أنّ علماء الاُصول قصدوا من الأخصّيّة والأعمّيّة والتساوي الأخصّيّة في الصدق والانطباق، والأعمّيّة أو التساوي فيه، فمعنى كون شيء أخصّ من شيء أنّه يصدق على بعض أفراده لا تمامها، ومعنى كونه أعمّ منه
(۱) لعلّ توضيح المقصود مايلي:
قصدوا بالعروض العروض المحلّيّ، فمتى ما فرضت واسطة خارجيّة بين العرض ومحلّه، فهذا يعني أنّ العرض عرض على تلك الواسطة، و تلك الواسطة عرضت على المحلّ، وكانت النسبة التصادقيّة بين تلك الواسطة والمحلّ هي التباين، وكان العرض عرضاً غريباً على المحلّ، ومثاله: تعمّق النوم الذي يكون عارضاً على النوم ويكون النوم عارضاً على الإنسان الذي هو المحلّ، ويكون النوم مبايناً في النسبة التصادقيّة مع الإنسان، فيكون عمق النوم عرضاً غريباً للإنسان، في حين أنّنا لو أخذنا النسبة المورديّة بين النوم والإنسان فالنسبة بينهما هي أعمّيّه النوم من الإنسان؛ لأنّ مورده الإنسان وكثير من الحيوانات الاُخرى، ولا نجد مثالاً للتباين.
أنّه يصدق على تمام أفراده وزيادة، ومعنى التساوي هو التساوي في الصدق والانطباق، أي: كلّ منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر دون غيره، فاضطرّوا إلى جعل عنوان في مقابل هذه العناوين وهو المباين، في حين ليس مراد الحكماء من الأعمّيّة والأخصّيّة والتساوي ذلك، بل مرادهم منها هو الأعمّيّة والأخصّيّة والتساوي في المورد، سواء كان منطبقاً عليه أو لا. وهذا هو الذي ينبغي أن يراد؛ لأنّ الميزان في ذاتيّة العرض مع الواسطة وعدم ذاتيّته هو كون الواسطة مساوية بالمعنى الثاني وعدمه، فلو أنّ عارضاً عرض على جوهر بواسطة عرض آخر ذاتيّ له، فهذه الواسطة وإن كانت مباينة للجوهر بالمعنى الأوّل ولكن مع ذلك يعتبر عرضها عرضاً ذاتيّاً للجوهر قد عرض عليه بواسطة أمر مساو، والسرّ في ذلك ما مضى من أنّ معلول المعلول معلولٌ، وأنّ ما يعرض ذاتاً على شيء عارض على شيء آخر بالذات عارض ذاتيّ له، ولذا صرّح المحقّق الطوسيّ في شرح الإشارات بأنّ العرض الذي يعرض على الشيء بواسطة أمر مساو من قبيل ما يعرض عليه بواسطة فصله، أو بواسطة عرض آخر مساو له يكون ذاتيّاً له. وعلى هذا الأساس فالمباين يرجع إلى أحد هذه الأقسام، أي: إلى الأعمّ أو الأخصّ أو المساوي.
الثاني: قد عرفت أنّ الملحوظ للحكماء هو الذاتيّة المنشَأيّة، لا الذاتيّة المحلّيّة، إلاّ أنّه قد يقال: إنّ المحل ـ وهو حامل العرض ـ أيضاً يكون منشأً وعلّة للعرض؛ وذلك لأنّه مادّة له، فهو أحد العلل الأربع عند الحكماء، حيث قالوا: إنّ الشيء بحاجة إلى أربع علل: العلّة الفاعليّة، والعلّة المادّيّة، والعلّة الصوريّة، والعلّة الغائيّة. إذن فالمحلّ يعدّ علّة للعرض؛ لأنّه علّة مادّيّة له. ولكن مع ذلك نقول: إنّ العرض لا يعتبر ذاتيّاً بالذاتيّة المنشَأيّة لمحلّه؛ والنكتةفي ذلك: أنّ المحلّ ليس علّة تامّة للعرض حتّى يستتبعه، فالخشبيّة مثلاً لا تكفي لتحقّق السريريّة حتّى تكون السريريّة ذاتيّة لها، فالعرض الذاتيّ للشيء هو الذي يكون ذلك الشيء مستتبعاً له وكافياً في تحقّقه، والمحلّ لا يلزم أن يكون كذلك بالنسبة إلى العرض. نعم، قد يتّفق أنّ المادّة سنخ مادّة فرضها يساوق فرض الفاعل والغاية كمادّة النبات التي تعرض لها أعراض من النموّ وطبع التغذية والحياة والموت، فمثل هذه الأعراض تعتبر ذاتيّة لمحلّها وإن كان فاعلها فوق الطبيعة، وليست نفس المادّة فاعلة لها؛ وذلك لأنّ الفاعل لا قصور فيه كالغاية، وإنّما ينتظر استعداد المادّة، فالمادّة تستتبع العرض لتماميّة باقي العلل، ولا نعني بالذاتيّة إلاّ أنّ فرض الشيء مساوق لاستتباعه للعرض، وعدمه مساوق لعدمه.
الثالث: أنّ العلّة الغائيّة حينما تكون باقي العلل مفروغاً عن ثبوتها تستتبع لا محالة ذا الغاية، فالغاية وإن كانت من ناحية معلولة لذي الغاية لكنّها من ناحية اُخرى تعدّ علّة ومنشأً لذي الغاية، وعلى هذا الأساس يصحّ أن يكون موضوع العلم عبارة عن الغاية، ويكون العلم باحثاً عن أسبابها، وذلك من قبيل علم الطبّ حيث يجعل موضوعه الصحّة، وهو يبحث عن حالات الإنسان والحركات والقوى الموجودة في جسم الإنسان إلى غير ذلك، حيث إنّه تفرض الصحّة غاية لكلّ تلك الاُمور، وقد ذهب الفلاسفة إلى أنّه كلّما يوجد شيء فهو بحاجة إلى علّة غائيّة، لا أنّ العلّة الغائيّة مرتبطة بفرض الاختيار في العمل، فالعلّة الغائيّة للأفعال والقوى والحركات في الجسم هي الصحّة، فتقع الصحّة موضوعاً لعلم الطبّ، ويتكلّم فيه عن أسبابها ومقدّماتها وموانعها أيضاً. هذا تمام الكلام في النقطة الاُولى، وبحسب الحقيقة قد ظهرت ممّا ذكرناه نكات حلّ الإشكال في النقطة الثانية والثالثة أيضاً.في ذلك: أنّ المحلّ ليس علّة تامّة للعرض حتّى يستتبعه، فالخشبيّة مثلاً لا تكفي لتحقّق السريريّة حتّى تكون السريريّة ذاتيّة لها، فالعرض الذاتيّ للشيء هو الذي يكون ذلك الشيء مستتبعاً له وكافياً في تحقّقه، والمحلّ لا يلزم أن يكون كذلك بالنسبة إلى العرض. نعم، قد يتّفق أنّ المادّة سنخ مادّة فرضها يساوق فرض الفاعل والغاية كمادّة النبات التي تعرض لها أعراض من النموّ وطبع التغذية والحياة والموت، فمثل هذه الأعراض تعتبر ذاتيّة لمحلّها وإن كان فاعلها فوق الطبيعة، وليست نفس المادّة فاعلة لها؛ وذلك لأنّ الفاعل لا قصور فيه كالغاية، وإنّما ينتظر استعداد المادّة، فالمادّة تستتبع العرض لتماميّة باقي العلل، ولا نعني بالذاتيّة إلاّ أنّ فرض الشيء مساوق لاستتباعه للعرض، وعدمه مساوق لعدمه.
الثالث: أنّ العلّة الغائيّة حينما تكون باقي العلل مفروغاً عن ثبوتها تستتبع لا محالة ذا الغاية، فالغاية وإن كانت من ناحية معلولة لذي الغاية لكنّها من ناحية اُخرى تعدّ علّة ومنشأً لذي الغاية، وعلى هذا الأساس يصحّ أن يكون موضوع العلم عبارة عن الغاية، ويكون العلم باحثاً عن أسبابها، وذلك من قبيل علم الطبّ حيث يجعل موضوعه الصحّة، وهو يبحث عن حالات الإنسان والحركات والقوى الموجودة في جسم الإنسان إلى غير ذلك، حيث إنّه تفرض الصحّة غاية لكلّ تلك الاُمور، وقد ذهب الفلاسفة إلى أنّه كلّما يوجد شيء فهو بحاجة إلى علّة غائيّة، لا أنّ العلّة الغائيّة مرتبطة بفرض الاختيار في العمل، فالعلّة الغائيّة للأفعال والقوى والحركات في الجسم هي الصحّة، فتقع الصحّة موضوعاً لعلم الطبّ، ويتكلّم فيه عن أسبابها ومقدّماتها وموانعها أيضاً. هذا تمام الكلام في النقطة الاُولى، وبحسب الحقيقة قد ظهرت ممّا ذكرناه نكات حلّ الإشكال في النقطة الثانية والثالثة أيضاً. →
→
ولكان الله تعالى موضوعاً لكلّ العلوم التي تتحدّث عن أيّ شيء في العالم؛ لأنّ الله تعالى منشأٌ لها جميعاً.
وعليه، فالصحيح هو جعل موضوع علم الاُصول العناصر المشتركة للاستنباط كما ورد في الحلقات الثلاث لاُستاذنا الشهيد(قدس سره) لا خصوص الأدلّة الأربعة أو الثلاثة، فإنّ جميع ما في علم الاُصول هو بحث عن العوارض المشتركة.
 →
→
ولكان الله تعالى موضوعاً لكلّ العلوم التي تتحدّث عن أيّ شيء في العالم؛ لأنّ الله تعالى منشأٌ لها جميعاً.
وعليه، فالصحيح هو جعل موضوع علم الاُصول العناصر المشتركة للاستنباط كما ورد في الحلقات الثلاث لاُستاذنا الشهيد(قدس سره) لا خصوص الأدلّة الأربعة أو الثلاثة، فإنّ جميع ما في علم الاُصول هو بحث عن العوارض المشتركة.
 →
→
ولكان الله تعالى موضوعاً لكلّ العلوم التي تتحدّث عن أيّ شيء في العالم؛ لأنّ الله تعالى منشأٌ لها جميعاً.
وعليه، فالصحيح هو جعل موضوع علم الاُصول العناصر المشتركة للاستنباط كما ورد في الحلقات الثلاث لاُستاذنا الشهيد(قدس سره) لا خصوص الأدلّة الأربعة أو الثلاثة، فإنّ جميع ما في علم الاُصول هو بحث عن العوارض المشتركة.
تقسيم الأبحاث الاُصوليّة
الجهة الثالثة ـ في تقسيم مباحث علم الاُصول: ذكر السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) أنّ قواعد الاُصول تنقسم إلى أربعة أقسام: ۱ ـ القواعد التي تؤدّي إلى العلم الوجدانيّ بثبوت الحكم، وهي أبحاث الاستلزامات كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته أو حرمة ضدّه. ۲ ـ القواعد التي توجب العلم التعبّديّ بالحكم، ويدخل تحتها صنفان: الأوّل: ما يكون البحث فيه عن صغرى الحجّة، كدلالة الأمر على الوجوب، والنهي على الحرمة، وظهور العامّ المخصّص في تمام الباقي. والثاني: ما يكون البحث فيه عن كبرى الحجّيّة، كحجّيّة ظهور الكتاب أو الشهرة أو خبر الواحد ونحو ذلك. ۳ ـ القواعد التي تقرّر الوظائف العمليّة الشرعيّة التي يرجع إليها الفقيه بعد العجز عن القسمين الأوّلين، كالبراءة الشرعيّة والاحتياط الشرعيّ. ٤ ـ الاُصول العمليّة العقليّة التي ينتهي الفقيه إليها بعد العجز عن القسم الثالثأيضاً، كقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وأصالة الاشتغال العقليّ(۱).
أقول: إنّنا نتصوّر للتقسيم لحاظين: اللحاظ الأوّل: هو لحاظ مراتب عمليّة الاستنباط بأن يقال: إنّ علميّة الاستنباط لها مراتب طوليّة لا تصل النوبة إلى بعضها مع التمكّن ممّا قبلها، فالقسم الأوّل عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الاُولى من الاستنباط، والقسم الثاني عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الثانية من الاستنباط، وهكذا. فإن كان نظر السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) إلى هذا اللحاظ كما لعلّه الظاهر من كلامه ورد عليه: أوّلاً: عدم الترتّب في عمليّة الاستنباط بين القسمين الأوّلين بناءً على ما هو المشهور المنصور من أنّ حجّيّة الأمارات غير مشروطة بانسداد باب العلم. نعم، هذا الإشكال الأوّل لا يرد لو كان المراد الترتّب لا بلحاظ ما ذكرناه من عمليّة الاستنباط المشتملة على الفحص، بل بلحاظ الوصول إلى بعض المراتب بالفعل، فإنّه مع الوصول إلى العلم الوجدانيّ لا تصل النوبة إلى العلم التعبّديّ. وثانياً: أنّه إذا كان الملحوظ الترتّب الطوليّ لمراتب عمليّة الاستنباط، وجب أن تجعل العلوم التعبّديّة التي جعلت قسماً ثانياً ذات مراتب أيضاً؛ لأنّ بعضها مترتّب على بعض آخر، فمثلاً التعبّد في جانب الدلالة مع قطعيّة السند مقدّم على التعبّد بالسند عندنا وعند السيّد الاُستاذ دامت بركاته. وثالثاً: أنّ الاستصحاب هو في طول الأمارات، وقبل الاُصول، فلماذا جعل مع
(۱) محاضرات الشيخ الفيّاض، ج ۱، ص ٦ ـ ۸ بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادىّ بقم، وكذلك ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئىّ، ص ۱ ـ ٤.
أيضاً، كقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وأصالة الاشتغال العقليّ(۱).
أقول: إنّنا نتصوّر للتقسيم لحاظين: اللحاظ الأوّل: هو لحاظ مراتب عمليّة الاستنباط بأن يقال: إنّ علميّة الاستنباط لها مراتب طوليّة لا تصل النوبة إلى بعضها مع التمكّن ممّا قبلها، فالقسم الأوّل عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الاُولى من الاستنباط، والقسم الثاني عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الثانية من الاستنباط، وهكذا. فإن كان نظر السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) إلى هذا اللحاظ كما لعلّه الظاهر من كلامه ورد عليه: أوّلاً: عدم الترتّب في عمليّة الاستنباط بين القسمين الأوّلين بناءً على ما هو المشهور المنصور من أنّ حجّيّة الأمارات غير مشروطة بانسداد باب العلم. نعم، هذا الإشكال الأوّل لا يرد لو كان المراد الترتّب لا بلحاظ ما ذكرناه من عمليّة الاستنباط المشتملة على الفحص، بل بلحاظ الوصول إلى بعض المراتب بالفعل، فإنّه مع الوصول إلى العلم الوجدانيّ لا تصل النوبة إلى العلم التعبّديّ. وثانياً: أنّه إذا كان الملحوظ الترتّب الطوليّ لمراتب عمليّة الاستنباط، وجب أن تجعل العلوم التعبّديّة التي جعلت قسماً ثانياً ذات مراتب أيضاً؛ لأنّ بعضها مترتّب على بعض آخر، فمثلاً التعبّد في جانب الدلالة مع قطعيّة السند مقدّم على التعبّد بالسند عندنا وعند السيّد الاُستاذ دامت بركاته. وثالثاً: أنّ الاستصحاب هو في طول الأمارات، وقبل الاُصول، فلماذا جعل مع
(۱) محاضرات الشيخ الفيّاض، ج ۱، ص ٦ ـ ۸ بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادىّ بقم، وكذلك ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئىّ، ص ۱ ـ ٤.
أيضاً، كقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وأصالة الاشتغال العقليّ(۱).
أقول: إنّنا نتصوّر للتقسيم لحاظين: اللحاظ الأوّل: هو لحاظ مراتب عمليّة الاستنباط بأن يقال: إنّ علميّة الاستنباط لها مراتب طوليّة لا تصل النوبة إلى بعضها مع التمكّن ممّا قبلها، فالقسم الأوّل عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الاُولى من الاستنباط، والقسم الثاني عبارة عمّا يكون دخيلاً في المرتبة الثانية من الاستنباط، وهكذا. فإن كان نظر السيّد الاُستاذ (دامت بركاته) إلى هذا اللحاظ كما لعلّه الظاهر من كلامه ورد عليه: أوّلاً: عدم الترتّب في عمليّة الاستنباط بين القسمين الأوّلين بناءً على ما هو المشهور المنصور من أنّ حجّيّة الأمارات غير مشروطة بانسداد باب العلم. نعم، هذا الإشكال الأوّل لا يرد لو كان المراد الترتّب لا بلحاظ ما ذكرناه من عمليّة الاستنباط المشتملة على الفحص، بل بلحاظ الوصول إلى بعض المراتب بالفعل، فإنّه مع الوصول إلى العلم الوجدانيّ لا تصل النوبة إلى العلم التعبّديّ. وثانياً: أنّه إذا كان الملحوظ الترتّب الطوليّ لمراتب عمليّة الاستنباط، وجب أن تجعل العلوم التعبّديّة التي جعلت قسماً ثانياً ذات مراتب أيضاً؛ لأنّ بعضها مترتّب على بعض آخر، فمثلاً التعبّد في جانب الدلالة مع قطعيّة السند مقدّم على التعبّد بالسند عندنا وعند السيّد الاُستاذ دامت بركاته. وثالثاً: أنّ الاستصحاب هو في طول الأمارات، وقبل الاُصول، فلماذا جعل مع
(۱) محاضرات الشيخ الفيّاض، ج ۱، ص ٦ ـ ۸ بحسب الطبعة الثالثة لدار الهادىّ بقم، وكذلك ج ٤۳ من موسوعة الإمام الخوئىّ، ص ۱ ـ ٤.
المقدّمة
۲
الوضع
○ حقيقة الوضع.
○ تشخيص الواضع.
○ الأقسام الممكنة للوضع.
○ ما هو الواقع من الأقسام الممكنة للوضع.
مسلك الاعتبار:
وأمّا المسلك الثاني: وهو مسلك الاعتبار، فيتشعّب إلى عدّة شعب على أساس اختلاف أرباب هذا المسلك فيما تعلّق به الاعتبار، فهنا عدّة وجوه يُفرض ما هو المُعتبر ـ أي: متعلّق الاعتبار ـ في بعضها غير ما هو المعتبر في البعض الآخر: الوجه الأوّل: أنّ متعلّق الاعتبار في الأوضاع اللُغويّة هو الوضع الخارجيّ، وتوضيح ذلك: إنّه لا إشكال في أنّ وضع شيء على شيء خارجاً يكون في كثير من الأحيان دالاًّ على شيء، فمثلاً ينصبون الأعلام على الأرض في أمكنة متباعدة بين فرسخ وفرسخ مثلاً لتعيين رؤوس الفراسخ، أو يُنصب علم على بئر لمعرفة وجود البئر هنا ونحو ذلك. وفي باب الأوضاع اللغويّة أيضاً يقصد وضع شيء على شيء، أي: وضع اللفظ على المعنى لتتمّ الدلالة، إلاّ أنّ الوضع الخارجيّ غير ممكن هنا حقيقة، فيوجد هذا الوضع الخارجيّ اعتباراً، أي: يعتبر أنّ اللفظ وضع على المعنى فتتمّيقول: إنّ الموضوع له والموضوع عليه في الوضع الخارجيّ قد يكونان متعدّدين في الوجود الخارجيّ، وقد يكونان متعدّدين بالتحليل لا بالوجود الخارجيّ، فمثلاً قد ينصب علَم على أرض للدلالة على وجود السبع في هذه الأرض، فيكون الموضوع عليه هو الأرض والموضوع له هو السبع، وهما متعدّدان بحسب الوجود الخارجيّ، وقد ينصب علَم على أرض للدلالة على رأس الفرسخ، فيكون الموضوع عليه هو الأرض والموضوع له هو رأس الفرسخ، وهما متّحدان في الوجود الخارجيّ متعدّدان بالتحليل، فالأرض بما هي هي وبغضّ النظر عن تحديدها تعتبر موضوعاً عليه، وبما هي رأس الفرسخ تعتبر موضوعاً له، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك بأن يفرض لفظ « الأسد » مثلاً موضوعاً، والمعنى المستعمل فيه على إجماله وبغضّ النظر عن تحديده وتعيينه موضوعاً عليه، وكون ذاك المعنى هو الحيوان المفترس موضوعاً له، فتعدّد الموضوع عليه والموضوع له بالتحليل، وصار الوضع هنا أيضاً ذا أركان ثلاثة، فارتفع الإشكال والاستغراب الأوّل، وهو: أنّه كيف أصبح هذا الوضع ذا ركنين؟ فإنّك عرفت أنّه أيضاً ذو أركان ثلاثة، غاية ما هناك: أنّه يكون التعدّد بين الموضوع له والموضوع عليه بالتحليل، وهذا ما يكون في كثير من موارد الوضع الخارجيّ أيضاً.
وبهذا يتّضح الجواب على الإشكال الثاني أيضاً، وهو: أنّ المعنى يجب أن يكون موضوعاً عليه، فإنّك قد عرفت أنّ المعنى وهو الحيوان المفترس موضوع له، وإنّما الموضوع عليه هو المستعمل فيه على إجماله. فقد ظهر: أنّ صاحب هذا الوجه بإمكانه دفع هذين الإشكالين. إلاّ أنّ الصحيح: أنّ أصل هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرّد تلاعب بالألفاظ. وتوضيح ذلك: أنّ هذا الوجه يفترض أنّه قد اعتبر في الأوضاع اللغويّة الوضعيقول: إنّ الموضوع له والموضوع عليه في الوضع الخارجيّ قد يكونان متعدّدين في الوجود الخارجيّ، وقد يكونان متعدّدين بالتحليل لا بالوجود الخارجيّ، فمثلاً قد ينصب علَم على أرض للدلالة على وجود السبع في هذه الأرض، فيكون الموضوع عليه هو الأرض والموضوع له هو السبع، وهما متعدّدان بحسب الوجود الخارجيّ، وقد ينصب علَم على أرض للدلالة على رأس الفرسخ، فيكون الموضوع عليه هو الأرض والموضوع له هو رأس الفرسخ، وهما متّحدان في الوجود الخارجيّ متعدّدان بالتحليل، فالأرض بما هي هي وبغضّ النظر عن تحديدها تعتبر موضوعاً عليه، وبما هي رأس الفرسخ تعتبر موضوعاً له، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك بأن يفرض لفظ « الأسد » مثلاً موضوعاً، والمعنى المستعمل فيه على إجماله وبغضّ النظر عن تحديده وتعيينه موضوعاً عليه، وكون ذاك المعنى هو الحيوان المفترس موضوعاً له، فتعدّد الموضوع عليه والموضوع له بالتحليل، وصار الوضع هنا أيضاً ذا أركان ثلاثة، فارتفع الإشكال والاستغراب الأوّل، وهو: أنّه كيف أصبح هذا الوضع ذا ركنين؟ فإنّك عرفت أنّه أيضاً ذو أركان ثلاثة، غاية ما هناك: أنّه يكون التعدّد بين الموضوع له والموضوع عليه بالتحليل، وهذا ما يكون في كثير من موارد الوضع الخارجيّ أيضاً.
وبهذا يتّضح الجواب على الإشكال الثاني أيضاً، وهو: أنّ المعنى يجب أن يكون موضوعاً عليه، فإنّك قد عرفت أنّ المعنى وهو الحيوان المفترس موضوع له، وإنّما الموضوع عليه هو المستعمل فيه على إجماله. فقد ظهر: أنّ صاحب هذا الوجه بإمكانه دفع هذين الإشكالين. إلاّ أنّ الصحيح: أنّ أصل هذا الوجه لا يعدو أن يكون مجرّد تلاعب بالألفاظ. وتوضيح ذلك: أنّ هذا الوجه يفترض أنّه قد اعتبر في الأوضاع اللغويّة الوضعالأسد أو زئيره ولو من دون إحساس خارجيّ، وأقصد بالاقتران المخصوص أن تكون للاقتران خصوصيّة كمّيّة من قبيل كثرة اقتران زئير الأسد بالأسد، أو خصوصيّة كيفيّة بأن يكون الاقتران في ظرف مؤثّر وملفت للنظر كما لو اقترن سفر شخص إلى الحلّة مثلاً بمرض شديد، فمتى ما تذكّر السفر إلى الحلّة تذكّر المرض.
والبشر قد استفاد منذ أبعد العصور في مقام التفهيم والتفاهم من هذين القانونين الثانويّين، فمثلاً تراه يفهّم بعض المعاني بإيجاد صورته باليد وغيرها، فلكي يشير إلى كون فلان لابساً للعمامة أو طويلاً أو قصيراً أو غير ذلك يشير باليد بنحو يصوّر صورة شبيهة بذلك، فينتقل ذهن المخاطب إلى المعنى المقصود، وهذا تطبيق للقانون الأوّل. ولكي يفهّم معنى الأسد يزئر كزئير الأسد فينتقل الذهن من هذا الصوت الشبيه بزئير الأسد إلى زئير الأسد تطبيقاً للقانون الأوّل، ومن زئير الأسد إلى معنى الأسد تطبيقاً للقانون الثاني، فيحصل بذلك تفهيم المعنى المقصود، ولكي يفهّم كون فلان شجاعاً مثلاً يزئر زئير الأسد مشيراً إليه، فينتقل ذهن السامع من صوته إلى زئير الأسد تطبيقاً للقانون الأوّل، ومن زئير الأسد إلى الأسد تطبيقاً للقانون الثاني، ومن الأسد إلى الشجاع للشبه الموجود بينهما تطبيقاً للقانون الأوّل، فبهذا يحصل تصوّر المعنى المقصود وهو الشجاع. وإلى هنا أمكن تكوين لغة للبشر يتفاهمون بها من باب الاستفادة من القانونين التكوينيّين من دون أيّ تصرّف من قبل البشر في كبرى القانون بأن يوجد سببيّة ذاتيّة في شيء لم يكن سبباً، ولا في صغرى القانون بأن يوجد الشبه أو المقارنة فيما لا يكون شبيهاً أو مقارناً، وإذا تكرّر إيجاد صوت يشبه صوت الأسد للدلالة على الشجاع ـ مثلاً ـ أصبح بالتدريج نفس ذلك الصوت دالاًّ على الشجاع من دون توسّط دلالته على صوت الأسد، ودلالة صوت الأسد على الأسد، ودلالة الأسد على الشجاع، وذلكلتكرّر المقارنة في الذهن بين هذا الصوت وبين الشجاع، فتوجد بهذه العمليّة صغرى لكبرى القانون الثاني، فيصبح هذا الصوت دالاًّ بكثرة الاستعمال على الشجاع. وهذا حقيقة الوضع التعيّنيّ الذي قالوا عنه: إنّه يحصل بكثرة الاستعمال، ثُمّ أصبح البشر بالتدريج متعوّداً على دلالة الأصوات على المعاني، وعلى الاستفادة من قانون المقارنة، فأصبحت الذهنيّة البشريّة مهيّأة للوضع بمعنى إقران لفظ بمعنى في الذهن للدلالة عليه، فيقرن الإنسان لفظاً بمعنىً من قبيل قرن لفظة « أسد » بمعناه، أو لفظة « حليب » بمعناه ونحو ذلك مرّة واحدة، لكنّه في ظرف مؤثّر من قبيل أن يقول: سمّيت ابني عليّاً، أو وضعت هذا الاسم عليه، أو اعتبرته عليّاً، وذلك أمام جماعة قد أنست أذهانهم من قبل بدلالة الأصوات على المعاني، والاستفادة من القرن، فيصبح هذا القرن في ظرف مؤثّر من هذا القبيل مُلفتاً للنظر، ويجعل اللفظ دالاًّ على المعنى، وتوجد بهذه العمليّة صغرى اُخرى لكبرى القانون الثاني، وهذا حقيقة الوضع التعيينيّ، فالوضع التعيينيّ والوضع التعيّنيّ كلاهما عبارة عن عمليّة إيجاد الاقتران بين اللفظ والمعنى حتّى يوجد بذلك صغرى من صغريات القانون الثاني، والفرق بينهما: أنّ الاقتران ـ الذي مضى: أنّه لابدّ أن يكون بنحو مخصوص حتّى يوجب الدلالة ـ يتمتّع في الوضع التعيّنيّ بخصوصيّة كمّيّة، وفي الوضع التعيينيّ بخصوصيّة كيفيّة، فروح الوضع والسبب الحقيقيّ للدلالة هو القرن بين اللفظ والمعنى في الذهن بنحو مخصوص(۱) سواء تحقّق

(۱) وفرق هذا البيان عن نظريّة بافلوف الشهيرة في قصّة دقّ الجرس أو نحو ذلك يمكن أن يفترض بأحد شكلين:
الأوّل: أن يقال: إنّ نظريّة بافلوف نظريّة فسلجيّة عضويّة، ونظريّة اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)
إنشاء وجعل، أو اعتبار وتنزيل، أو وضع للّفظ على المعنى، أو تحت المعنى، أو لا، فالتفتيش عن نكتة الوضع والدلالة في كون الوضع اعتباراً أو تنزيلاً أو غير ذلك ليس إلاّ مجرّد تلاعب بالألفاظ.
وقد اتّضح ممّا بيّناه عدّة اُمور: الأوّل: أنّ الصحيح في الوضع هو مسلك الواقعيّة، لكنّه لابدّ من بيان السرّ ونكتة الدلالة والوضع، وهذا ما صنعناه، لا مجرّد أن يقال: « إنّ الواضع يجعل اللفظ سبباً واقعيّاً للدلالة »، وليس روح الوضع عبارة عن أمر إنشائيّ حتّى يتكلّم →
→
نظريّة سيكولوجيّة نفسيّة، فذاك يقول: إنّ الأثر المادّيّ للطعام ـ ويفترضه سيلان اللعاب ـ سرى إلى ما قارن الطعام لدى الكلب (راجع فلسفتنا، ص ۳۷۲ ـ ۳۷٤ بحسب طبعة منشورات عويدات ببيروت، واقتصادنا، ص ٥٤ ـ ٥۷ بحسب طبعة دار الفكر ببيروت). وإسراء ذلك إلى الفكر واللغة من قبل بعض الماديّين يعني: أنّ النشاط المخّيّ المادّيّ الذي يحصل بالإحساس بالشيء يحصل أيضاً بسماع اللفظ المقترن بذلك الشيء. وهذا المطلب لا دليل على صحّته، وتجربة بافلوف لا ينحصر تفسيرها بذلك، فبالإمكان أن تفسّر بأنّ سيلان اللعاب لم يكن أصلاً استجابة لذات الطعام المادّيّ بل كان استجابة للصورة الذهنيّة اللامادّيّة التي هي وراء النشاط المخّيّ المادّيّ، وبما أنّ صوت الجرس المقارن لتقديم الطعام أعطى نفس الصورة للذهن حصلت نفس الاستجابة؛ ولذا ترى أنّ ما يكون حقّاً نتيجة لذات المادّة كالموت بالنسبة للسمّ، أو الشفاء بالنسبة للدواء لا يسري إلى ما يقارن تلك المادّة من لفظ أو غيره، وأمّا اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) فإنّما قال بتماثل المتقارنين في خلق الصورة العقليّة الميتافيزيقيّة لدى الفكر اللامادّيّ.
والثاني: أن يفترض أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) لا يقول أصلاً بانتقال الأثر من شيء إلى ما يقارنه، وإنّما يقول: بأنّ التقارن الأكيد في الذهن يجعل تصوّر القرين سبباً للانتقال إلى قرينه من دون فرضيّة اكتساب أحد القرينين آثار قرينه الآخر، بينما نظريّة بافلوف هي نظريّة انتقال الأثر من القرين إلى القرين.
في أنّه هل هو تنزيل أو اعتبار؟ وأنّه هل يعتبر اللفظ نفس المعنى، أو أداة للدلالة على المعنى، أو فوق المعنى، أو تحت المعنى ونحو ذلك من العبارات والتلاعبات بالألفاظ؟ نعم، كثيراً ما يتّفق أنّ الواضع ينشئ شيئاً من اعتبار أو نحوه، فيقول بقصد الإنشاء: سمّيت ابني عليّاً، إلاّ أنّ هذه العمليّة لها جنبتان: جنبة الإنشاء، كأن ينشئ وضع اللفظ فوق المعنى أو تحته أو نحو ذلك، وجنبة إيجاد اقتران واقعيّ وحقيقيّ في الذهن بين اللفظ والمعنى بنحو مخصوص، والجنبة الثانية هي سرّ الوضع والدلالة دون الاُولى؛ ولذا قد تتمّ الدلالة على أساس الجنبة الثانية مع فقدان الجنبة الاُولى، كما لو سمع الطفل من اُمّه كلمة الحليب مقترنةً بتقديم الحليب له من دون أن يُنشأ أمامه شيء، أو يستطيع أن يتعقّل الإنشاء، فتتمّ في ذهنه الدلالة تارة بتكرّر الاقتران كثيراً، واُخرى بالاقتران مرّة واحدة أو عدداً قليلاً من المرّات إذا كان ذكيّاً، فمتى ما سمع كلمة الحليب انتقل ذهنه إلى معناه.
الثاني: أنّ الوضع يوجب الدلالة التصوّريّة للّفظ ولو سمع من جدار، ولا يوجب الدلالة التصديقيّة، وإنّما الدلالة التصديقيّة تكون وليدة اُمور اُخرى من ظاهر حال وقرائن أحوال ونحو ذلك، وهذا واضح على ما عرفت من أنّ روح الوضع عبارة عن الاقتران في الذهن بين اللفظ والمعنى، وإيجاد الصغرى للقانون الثاني من القانونين التكونيّين الثانويّين، فإنّ من الواضح: أنّ ذاك القانون مفاده إنّما هو انتقال الذهن من أحد المتقارنين إلى الآخر من دون دلالة تصديقيّة، ولا تعقل دلالة اللفظ على المعنى دلالة تصديقيّة إلاّ على مسلك التعهّد، حيث تعهّد الإنسان مثلاً بأن لا يتكلّم بالكلام الفلانيّ إلاّ إذا قصد المعنى الفلانيّ، فكلامه كاشف عن تحقّق ذاك القصد، وأمّا مجرّد الاعتبار كما هو المسلك الثاني، أو خلق سببيّة اللفظ واقعاً لانتقال الذهن إلى المعنى كما هو المسلك الثالث، أو عمليّة القرنكما هو المختار في تعميق المسلك الثالث وتكميله، فكلّ هذا لا يعطي للّفظ الدلالة التصديقيّة، فإنّ مجرّد اعتبار اللفظ معنىً، أو اعتباره على المعنى، أو دالاًّ عليه بعد فرض كفايته لانتقال الذهن إلى المعنى لا ربط له بالتصديق بإرادة المتكلّم لذلك المعنى، وكذلك الإيجاد الواقعي للسببيّة في اللفظ لانتقال الذهن إلى المعنى، فإنّ هذا لا علاقة له بالكشف عن إرادة المتكلّم له، وعمليّة القرن أيضاً إنّما توجب انتقال الذهن من أحد المتقارنين إلى الآخر، لا الكشف عن شيء.
وقد ذكر السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ: أنّ الدلالة التصوّريّة في اللفظ المسموع من الجدار لا يصحّ فرضها دلالة وضعيّة؛ لأنّ الهدف من الوضع إنّما هو التفهيم والتفاهم بين العقلاء، وأمّا الجدار الذي لا يعقل ولا يريد شيئاً، فمدّ الوضع إلى ما يسمع منه لغو ولا فائدة فيه، ويكون خلاف حكمة الواضع(۱). وأنت ترى: أنّ هذا البيان لا موضوع له بناءً على ما بيّناه من أنّ الوضع هو أن يوجد الواضع في اللفظ ما هو سبب ذاتاً للدلالة، وهو الاقتران، وسببيّة الاقتران للدلالة تكوينيّة، ولا تفكيك فيها بين مورد يوجد فيه هدف الواضع ومورد لا يوجد فيه هدفه، فالواضع حينما قرن اللفظ بالمعنى تمّت الدلالة مطلقاً شاء أو أبى، ولا يمكنه أن يفكّك بين ما يُسمع من إنسان فيكون دالاًّ وما يسمع من جدار فلا يكون دالاًّ(۲).
(۱) راجع المحاضرات للشيخ الفيّاض حفظه الله، ج ۱، ص ٤۹ و ۱٠٤ ـ ۱٠٥.
وقد أتى في الموضع الثاني ـ أعني: ص ۱٠٤ ـ ۱٠٥ ـ بهذا البيان لإثبات عدم إطلاق الوضع للّفظ الصادر من لافظ غير ذي شعور حتّى على مسلك الاعتبار، أمّا على مسلك التعهّد فهو ليس بحاجة إلى هذا البيان، أعني: بيان لزوم اللغويّة؛ وذلك لأنّ التعهّد من اللافظ غير ذي شعور لا معنى له.
(۲) هذا بناءً على المسلك المختار، وهو مسلك القرن الأكيد. والواقع: أنّنا حتّى لو
 →
→
تكلّمنا على مسلك الاعتبار مثلاً، فبرهان اللغويّة الذي ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) لنفي إطلاق الوضع للّفظ الصادر من غير ذي شعور غير صحيح؛ وذلك لأنّ الإطلاق ليست فيه مؤونة زائدة كي تُنفى باللغويّة.